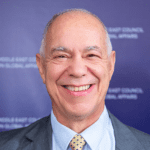تلقي التوتّرات المتصاعدة بين الولايات المتّحدة والصين بظلالها على منطقة المغرب العربي. وعلى الرغم من أنّها ليست ساحة مواجهة مباشرة، يجد المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا أنفسهم في مهبّ التنافس المحتدم بين القوى العظمى، مع ما يترتّب على ذلك من تداعيات اقتصادية وسياسية وأمنية وتكنولوجية. وفي مواجهة هذا الواقع، سعت هذه الدول إلى احتواء التوتّرات بحنكة، وبل توظيفها أحياناً لتحقيق المكاسب من واشنطن وبكين على حدّ سواء. غير أنّه مع تفاقم حدّة الصراع وتزايد الضغوط على الحكومات للاصطفاف مع أحد الطرفين، ستصبح جهود المحافظة على هذا التوازن الدقيق تحدّياً هائلاً ومهمة شاقة.
يوفّر التنافس بين الولايات المتّحدة والصين فرصاً كما ينطوي على مخاطر. بالنسبة إلى دول الجنوب، يشكّل التعاون مع بكين وسيلة لموازنة نفوذ القوى الكبرى الأخرى، ومن ضمنها الحلفاء مثل الولايات المتّحدة والقوى الاستعمارية الأوروبية السابقة. وبينما تحتفظ الجزائر بعلاقات سياسية وثيقة مع الصين، فإنّ بقية دول المغرب العربي يغلب على علاقتها مع الصين الطابع الاقتصادي، إذ تساهم في دفع عجلة تطوير البنية التحتية في المنطقة، كما توفّر للشركات الصينية مجالات لتصريف فائض طاقتها الإنتاجية. وقد انضمّت جميع دول المغرب العربي إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية، ووقّعت اتفاقيات مع بكين في مسعى لاستثمار حدّة التنافس الصيني الأمريكي لتعظيم نصيبها من المساعدات والاستثمارات والاهتمام الدبلوماسي من الجانبين. غير أنّ هذا التوازن بات أكثر هشاشة.
تجنّب الاصطفاف الحصري
تتباين التوجّهات الإستراتيجية لدول المغرب العربي، غير أنّ جميعها تتأثّر بإعادة رسم موازين القوى العالمية. فالجزائر، بحكم إرثها المناهض للاستعمار وتقاليدها الراسخة في عدم الانحياز، لطالما فضّلت إقامة الشراكات مع الصين وروسيا. ومنذ العام 2013، باتت الصين الشريك التجاري الأول للجزائر، وقد توسّع التعاون بين الجانبين ليشمل معظم القطاعات. في المقابل، يحافظ المغرب على علاقة وثيقة مع الولايات المتّحدة، تُجسّدها اتفاقية التجارة الحرّة المُبرمة في العام 2006. كما تعزّزت هذه العلاقة بتوقيع اتفاقية التعاون العسكري لعشر سنوات في العام 2020 ما يعكس متانة الشراكة الأمنية بين المغرب والولايات المتّحدة. ومع ذلك، لم يتردّد المغرب في فتح أبوابه أمام الاستثمارات الصينية، لا سيّما في قطاعي الطاقة المتجدّدة وصناعة السيارات. وتسير تونس وليبيا وموريتانيا على النهج نفسه، إذ تسعى إلى تنويع شراكاتها وتفادي الاصطفاف الحصري مع أي من القوى الكبرى.
في الوقت الراهن، لا تزال دول المغرب العربي قادرة على توظيف موقعها الجيوسياسي لعقد شراكات متنوّعة، في ما يشبه إستراتيجية التحوّط التي تعزّز استقلاليتها السياسية وتعظّم مكاسبها الاقتصادية. لكن، في حال تصاعد حدّة التنافس بين الصين والولايات المتّحدة وتحوّل إلى نظام عالمي ثنائي القطب يُجبر الشركاء على الانحياز إلى جانب أحد المعسكرين، فإنّ هامش المناورة المتاح لهذه الدول سيتقلّص إلى حدّ كبير.
مناطق النفوذ
بعد وقت قصير من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، وقّعت الولايات المتّحدة والجزائر أول اتفاقية تعاون عسكري بينهما. ومن المرجّح أن تكون واشنطن قد رأت في الاتفاق وسيلة لكبح جماح النفوذ المتزايد لكلّ من الصين وروسيا في أفريقيا. أمّا بالنسبة إلى الجزائر، فيساعد الاتفاق على موازنة العلاقات العسكرية الوثيقة بين الولايات المتّحدة والمغرب، التي تتضمّن تدريبات عسكرية مشتركة منتظمة، مثل مناورات «الأسد الأفريقي» السنوية بين القوّات المسلّحة الملكية المغربية والقيادة الأمريكية في أفريقيا، إلى جانب برامج المساعدات والتدريب العسكري. وتُعدّ تونس بدورها من أبرز المستفيدين من الدعم الأمني الأمريكي، فقد وقّعت مع واشنطن «خارطة طريق للتعاون الدفاعي» لعشر سنوات في أكتوبر 2020.
تمتلك الجزائر أسباباً وجيهة لتوخي الحذر من إدارة ترامب. فقبيل مغادرته منصبه في العام 2020، تخلّى ترامب عن سياسة الحياد التقليدية التي تتبعها الولايات المتّحدة حيال ملف الصحراء الغربية، عبر اعترافه بسيادة المغرب على الإقليم، في مقابل انضمام الرباط إلى اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل. وقد أعادت إدارة ترامب الثانية التأكيد على هذا الموقف، ما دفع الجزائر إلى التعبير عن «أسفها». ومع ذلك، يبدو أنّ واشنطن تتبنّى مقاربة جديدة حيال هذا الصراع. ففي مقابلة أجريت في أبريل الماضي، أشار كبير مستشاري ترامب لشؤون أفريقيا، مسعد بولس، إلى أنّ واشنطن تسعى إلى تسوية تُرضي طرفي الصراع الممتدّ منذ نصف قرن، وتبيّن تصريحاته عن أهمية الجزائر بالنسبة إلى المصالح الأمريكية، احتمال وجود تباين في مواقف واشنطن أو تحوّل محتمل في توجّهاتها السياسية. وعلى أي حال، ستظل الجزائر متوجّسة من خطوات ترامب، لا سيّما في ظلّ مواقف وزير الخارجية ماركو روبيو الذي سبق أن انتقد علاقات الجزائر الدفاعية الوثيقة مع روسيا. ومن الواضح أنّ الجزائر ماضية في الحفاظ على هذه العلاقات، إلى جانب تعزيز علاقاتها العسكرية مع الصين.
وفي أبريل الماضي، وقّعت الجزائر وبكين عشر اتفاقيات رئيسة في قطاعات حيوية متنوعة. غير أنّ الجزائر، وتماشياً مع مبادئها في عدم الانحياز وسعيها الدؤوب لتنويع اقتصادها، حرصت أيضاً على توطيد علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتّحدة، لا سيّما في قطاع الطاقة، إذ وُقعت عقوداً مهمّة مع شركات أمريكية مثل «أوكسيدنتال» (Occidental) و«شيفرون» (Chevron) و«إكسون موبيل» (Exxon Mobil). وتأمل الجزائر في جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية مستفيدة من قانون الاستثمار الذي أقرّته في العام 2022.
بدوره، سلك المغرب أيضاً مساراً دقيقاً ومتوازناً. وعلى الرغم من علاقاته الوثيقة مع الولايات المتّحدة، لم يتردّد في فتح أبوابه أمام الاستثمارات الصينية، خصوصاً في قطاعي الطاقة المتجدّدة وصناعة السيارات، كما عزّز علاقاته التجارية مع بكين.
وطوّرت تونس، التي تُعدّ حليفاً رئيساً من خارج الناتو، علاقات اقتصادية أوثق مع الصين، ووقّعت معها شراكة إستراتيجية في مايو 2024، ما أسهم في ترسيخ موقع الصين كأحد أبرز شركاء تونس التجاريين. وفي ظلّ الأزمة المالية الخانقة، من المرجّح أن تسعى تونس للحصول على مساعدات من الولايات المتّحدة، غير أنّ إدارة ترامب قد تشترط تقديم هذه المساعدات بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهي خطوة يبدو أنّ الرئيس الشعبوي قيس سعيّد متردّد في الإقدام عليها. وإذا ما فُرض هذا الشرط، فقد تجد تونس نفسها أقرب إلى بكين. والواقع أنّ النظام التونسي الذي يزداد سلطوية قد يجد نقاط تقاطع مصالحه مع النموذج السياسي الاقتصادي الصيني، حتى مع استمرار علاقاته العسكرية والأمنية الوثيقة مع واشنطن.
أمّا في ليبيا، فقد كانت مشاركة إدارة ترامب محدودة نسبياً، إذ ركّزت على الإستراتيجية الإقليمية الأشمل وجهود مكافحة الإرهاب. في البداية، دعمت إدارة ترامب الأولى حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتّحدة، لكنها تسبّبت في إرباك السياسة الأمريكية حين أشاد ترامب شخصياً، في العام 2019، بالقائد العسكري في الشرق خليفة حفتر. واليوم لا تزال الدولة الليبية منقسمة، تديرها حكومتان متنافستان، ويستمر فيها الصراع، في مشهد شديد التعقيد تمارس فيه قوى خارجية مثل تركيا وروسيا والإمارات نفوذاً أكبر بكثير من الصين أو الولايات المتّحدة.
حافظت الصين على موقف دبلوماسي محايد، وامتنعت، على غرار واشنطن، عن التورّط في الصراعات الداخلية الليبية. لكن في حال استقر المشهد السياسي الليبي واستؤنفت مشاريع الطاقة، فقد تعود احتمالات التنافس الأمريكي الصيني إلى الواجهة. فعندئذ، قد تتحوّل ليبيا إلى ساحة نشطة لـ«دبلوماسية البنى التحتية»، خصوصاً إذا بدأت عملية إعادة الإعمار بشكل جاد، وهو ما تطمح الصين إلى تأدية دور محوري فيه.
وعلى الرغم من تمسك الصين بموقف الحياد، تميل الفصائل الليبية المتنافسة إلى الاصطفاف ضمن تكتلات دولية متباينة، بعضها أقرب إلى الصين وروسيا، فيما يقترب البعض الآخر من الدول الغربية. وفي حال استقرّ النظام الدولي على تعددية قطبية، فقد تعيد الصين والولايات المتّحدة استثمار جهودهما في إعادة إعمار ليبيا. ويمكن أن تستفيد البلاد حينها من هذا التنافس العالمي في مشاريع التنمية والبنية التحتية. ولكن إذا تصاعدت حالة الاستقطاب الثنائي على المستوى الدولي، فقد تصطف الفصائل الليبية مع معسكرات متعارضة، ما من شأنه أن يفاقم حالة عدم الاستقرار، ويؤدّي إلى تحوّل ليبيا إلى ساحة صراعات بالوكالة، ويُعيق جهود إعادة الإعمار. في الوقت الراهن، ستبقى الولايات المتّحدة يقظة تجاه التهديدات الأمنية المنبعثة من ليبيا، وستسعى إلى مواجهة تنامي نفوذ القوى المنافسة، مع تجنّب التورط العسكري أو الدبلوماسي العميق.
وفي ما يتعلّق بموريتانيا، يركّز نهج إدارة ترامب على مكافحة الإرهاب، ويتعامل مع المساعدات الخارجية بمنطق الصفقات، مع إغفال شبه تام لقضايا تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان. وتُعدّ موريتانيا، الدولة الأفقر في المغرب العربي، خارج دائرة الأولويات الأمريكية، غير أنّ تعاونها في ملف مكافحة الإرهاب يتماشى مع المصالح الأمريكية في منطقة الساحل المضطربة. وللحدّ من النفوذ الصيني والروسي، تسعى إدارة ترامب إلى دعم الشركات الأمريكية في منافستها مع الحضور الصيني في القطاعات الأساسية. لقد حافظت الصين، التي تُعدّ الشريك التجاري الرئيس لموريتانيا، على تعاون اقتصادي مستقر معها على الرغم من التبدّل المتكرّر للحكومات في نواكشوط.
وستركّز الجهود الأمريكية غالباً على تقليص نفوذ روسيا العسكري والسياسي. لكن انتقال واشنطن من نموذج المساعدات التقليدية إلى تشجيع القطاع الخاص في أفريقيا، عبر تحويل المنح إلى قروض تحفّز النمو الاقتصادي عبر الاستثمار، قد لا يكون جذاباً لدول مثل موريتانيا. وتُشكّل مشاريع بناء الموانئ أحد أهم عناصر مبادرة الحزام والطريق الصينية، إذ تربط هذه الموانئ بين دول تمتلك الصين فيها مصالح إستراتيجية وتمنحها ميزة جيوسياسية. كما تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز التكامل الاقتصادي في غرب أفريقيا. وقد تتعرّض موريتانيا لضغوط لتقييد دور الصين في مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالأمن أو في الموانئ، لكن هذا الوضع قد يمنحها فرصة للحصول على مساعدات واستثمارات إضافية من الجانبين، شرط أن تحافظ على استقرارها السياسي.
ممارسة الوكالة السياسية
لم تعد دول المغرب العربي تكتفي بتأدية دور المراقب السلبي فحسب، بل باتت طرفاً فاعلاً في التنافس العالمي الدائر بين الولايات المتّحدة والصين. وعلى الرغم من أنّها لا تُعدّ من اللاعبين المركزيين في هذا التنافس، إلّا أن موقعها الإستراتيجي، ومواردها الوفيرة، وحاجاتها المتزايدة للبنية التحتية، تجعلها ذات أهمية متزايدة في الجغرافيا السياسية العالمية.
حتى الآن، نجحت حكومات المنطقة في تحقيق توازن دقيق بين المصالح المتنافسة عبر ما يُعرف بـ «التحوّط الإستراتيجي». ومع تصاعد التوتّرات بين الولايات المتّحدة والصين، وتحوّلها إلى مواجهة أكثر حدّة وتصلّباً، قد تواجه دول المغرب العربي ضغوطاً متزايدة للانحياز في مصالحها الاقتصادية والتكنولوجية إلى أحد المعسكرين. وتجسّد قرارات عدد من الحكومات الأفريقية بفتح أسواقها أمام شركة الاتصالات الصينية «هواوي» (Huawei) تجاهلاً واضحاً لمحاولات واشنطن المتكرّرة لردعها عن التعاون مع الشركة وسواها من الشركات الصينية. ومع ذلك، فقد تواجه المشاريع التي تعتمد على بنية تحتية لشبكات الجيل الخامس من «هواوي» في الجزائر أو تونس عقبات مستقبلية، إذ قد تؤدّي العقوبات الأمريكية المفروضة على الشركات الصينية إلى إحجام الشركات الغربية عن الدخول في مشاريع مشتركة معها.
للحفاظ على استقلالها الإستراتيجي، ينبغي على دول المغرب العربي أن تركّز على تنويع شراكاتها، وتعزيز التعاون الإقليمي، والاستثمار في بناء قدراتها المؤسّسية لإدارة النفوذ الأجنبي بفعاليّة. يكمن سرّ النجاح في ظلّ التنافس العالمي في ممارسة الفاعلية السياسية، أي اقتناص الفرص من دون التفريط في السيادة.