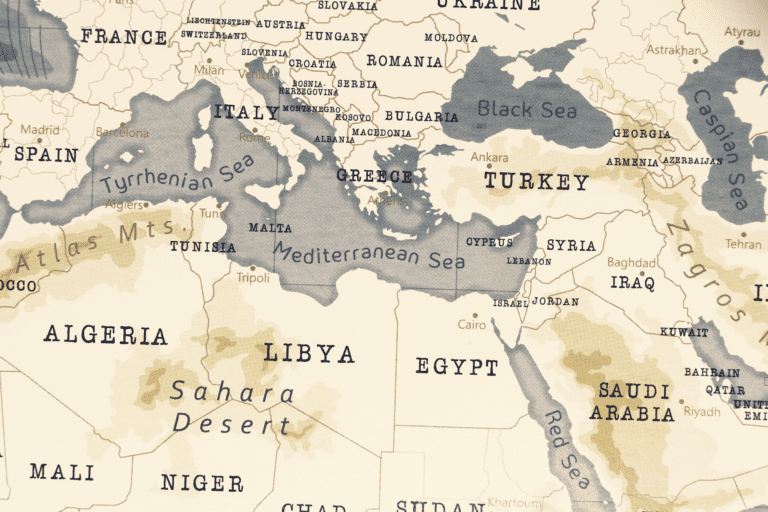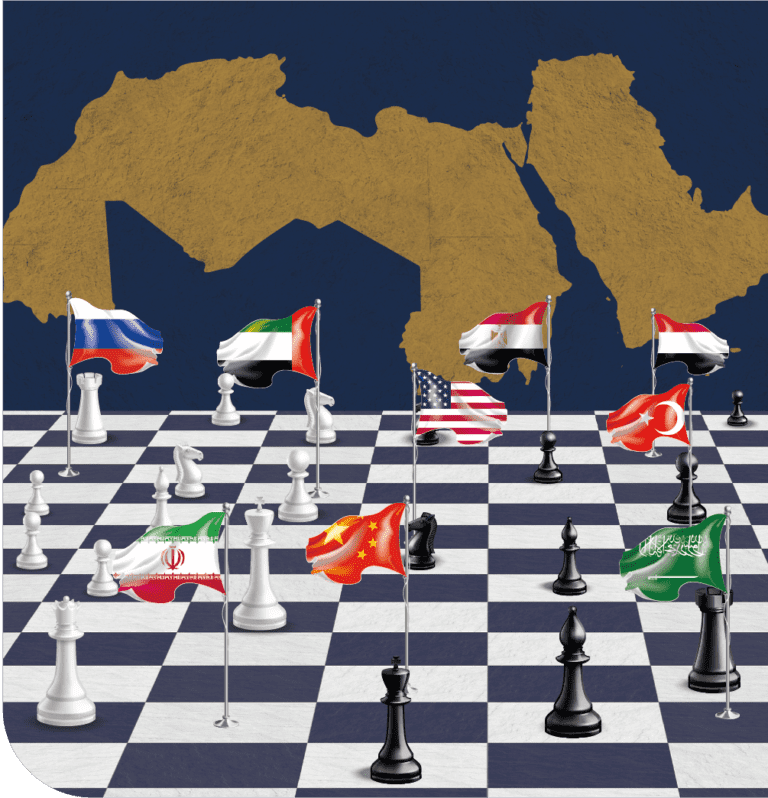سياسة تركيا الخارجية في عالم مضطرب
موجز قضية، مايو 2024
النقاط الرئيسيّة
تركيا تتمسّك بسعيها لتعزيز استقلاليتها ومكانتها: من المتوقّع أن تلقي المخاوف الاقتصادية بظلّها على السياسة الخارجية التركية، مع ذلك ستواصل أنقرة سعيها لتدعيم سياستها الخارجية المستقلّة وتعزيز مكانتها الدولية.
الشرق الأوسط كنموذج: يقدّم الشرق الأوسط بالفعل نموذجاً على رؤية أنقرة الجديدة المدفوعة بالاقتصاد. والتقارب بين تركيا والدول الخليجية جارٍ على قدم وساق، بحيث يبقى الاقتصاد في صلب هذا التقارب.
مثلّث العلاقة التركية الروسية الغربية: ستسعى تركيا للحفاظ على توازن جيوسياسي في علاقتها مع روسيا والغرب، ما قد يضع التعاون الدفاعي بينها وبين موسكو على المحكّ. وقد يؤجّج اهتمام أنقرة المتنامي بـ”العالم التركي” مع روسيا. في المقابل، تشهد علاقاتها مع الغرب نوعاً من التحسّن، على الرغم من الأزمات التي لا تزال عالقة.
تنامي دور وزارة الخارجية: سيتنامى دور وزارة الخارجية التركية مقارنةً بالمؤسسّات الأخرى، تحت قيادة اسم موثوق ومتنفّذ هو هاكان فيدان. وعلى الأرجح أن تصبح الدبلوماسية التركية أكثر احترافيةً من حيث اللغة والأسلوب.
المقدّمة
شهدت السياسة الخارجية التركية في العام الماضي تطوّرات بارزة تردّد صداها على نطاق واسع. فبعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة عام 2023، عيّن هاكان فيدان في منصب وزير الخارجية وإبراهيم قالن رئيساً لجهاز الاستخبارات، وكلاهما من الشخصيات الوازنة في البلاد. في غضون ذلك، تعطّل قطار التطبيع مع إسرائيل الذي ركبته دول إقليمية، بينها تركيا، إثر هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر، وغزو إسرائيل لقطاع غزة الذي لحقه. في المقابل، يخيّم اليوم مناخ إيجابي على علاقة تركيا مع الغرب بعد سنوات من الأزمات والتوتّرات، ما قد يرخي بظلاله على علاقة أنقرة مع موسكو. كلّ ذلك في ظلّ ركود اقتصادي محلّي ألقى بثقله على السياسة الخارجية التركية. بالتالي، أصبح الوقت مناسباً اليوم للتمعّن في التأثير التراكمي لهذه التطورات على سياسة تركيا الخارجية وعلى إطارها العام ومسارها، لا سيما في ما خصّ علاقاتها مع دول الشرق الأوسط وروسيا والغرب.
يرجّح موجز القضيّة هذا أنّ تركيا ستتمسّك بسعيها لتعزيز استقلاليتها ومكانتها الدولية التي لطالما شكّلت سياستها الخارجية، حتى في ظلّ هذه الديناميات المتغيّرة. إلى ذلك، سيتنامى تأثير العامل الاقتصادي على السياسة الخارجية. وكان فيدان ركّز في مقالته الأولى كوزير للخارجية على أنّ “الجانب الاقتصادي سيلقى عناية خاصة في الفترة المقبلة”،[1] حيث يُرجّح أن تفاقم التحديات الاقتصاديّة التركية هذه الدينامية.
ويشكّل الشرق الأوسط نموذجاً على هذه السياسة الخارجية التركية الجديدة المرتكزة على الاقتصاد، فالتقارب التركي الخليجي الحالي انطلق في الأساس من اعتبارات اقتصادية. ولكن لا شكّ أنّ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة أعطت بعداً إضافياً لحسابات تركيا الأمنية والجيوسياسية، ودفعتها للتراجع عن مسار التطبيع مع تل أبيب.
في ما خصّ مثلّث العلاقة التركية الروسية الغربية، ستسعى أنقرة على الأرجح للحفاظ على هذا التوازن الجيوسياسي، على الرغم من بعض التغيّرات التي قد تطرأ على التفاصيل. مثلاً، يُستبعد أن تبرم أنقره أيّ اتفاقيات دفاعية جديدة مع موسكو عبر شراء منظومة أسلحة متطوّرة، نظراً للتوتّرات التي طرأت على علاقتها مع الولايات المتحدة على خلفية شرائها منظومة صواريخ “أس-400” الروسية عام 2017، ما تسبب بشرخ كبير مع واشنطن.[2]
إلى ذلك، اكتسب مفهوم “العالم التركي”[3] أهميّة متزايدة في سياسة تركيا الخارجية، ملقياً بظلّه على علاقاتها مع روسيا. فدول “العالم التركي” بحسب تصوّر أنقرة، تمتد بين آسيا الوسطى وجنوب القوقاز، وقد يؤدّي تنامي أهميّة هذا التصوّر في سياسة تركيا الخارجية إلى تأجيج التوترات مع روسيا وإيران والصين، حيث لكلّ من هذه الدول أسبابها الخاصة للقلق. بالنسبة إلى الكرملين، “العالم التركي” هو ما يصنّفه بـالخارج القريب الواقع ضمن منطقة النفوذ الطبيعي لموسكو، في حين تحتضن كلّ من إيران والصين مجموعات سكّانية تركية وازنة، سواء الأذريين في إيران أو الأيغور في الصين.
بالإضافة إلى ذلك، من المُستبعد أنّ تُحلّ قريباً الأزمات البنيوية التي تواجه العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، منها الافتقار إلى إطار فعّال يحكم هذه العلاقة، ولخلافات الجوهرية بين تركيا والغرب. مع ذلك، تتّجه هذه العلاقات نحو التحسّن مع اكتساب الطرفين خبرة في إدارة الخلافات بينهما وتجزئة المسائل الخلافية. ولعلّ التقارب التركي اليوناني ومصادقة أنقرة على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي وموافقة الولايات المتحدة على بيع طائرات “أف -16” إلى تركيا أبرز أمثلة على هذا المناخ المستجد.[4]
دوام السعي للاستقلالية الإستراتيجية
يرتكز الإطار العام للسياسة الخارجية التركية المعاصرة على تعزيز استقلالية البلاد من حيث السياسة الخارجية والأمنية وتوسيع دورها الإقليمي وتعزيز مكانتها الدولية، وهذا ما يُستبعد أن يتغيّر في المستقبل القريب. إذ تقدّم تركيا مثالاً عن نهج جديد يكتسب زخماً في السياسة الدولية نظراً لتصدّرها القوى المتوسطة التي تسعى للاضطلاع بأدوار إقليمية أكبر، وترسيخ استقلاليتها في السياسة الخارجية، وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.[5]
ولعلّ مواقف القوى الإقليمية تجاه غزو أوكرانيا أوضح مثال على هذا النهج الجديد. فقد تبنّت قوى غير غربية، مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند، سياسات محايدة لم تلق رضاً غربياً، وذلك انطلاقاً من سعي هذه الدول لبناء سياساتها الخارجية المستقلّة، ولكن أيضاً بسبب خيبتها من الولايات المتحدة والغرب بشكل عام. إذ يرى كثيرون، بخاصة في الشرق الأوسط، أنّ هذا النهج يعكس تبادل الأدوار بين روسيا والولايات المتحدة على الساحة الإقليمية. فقد عزّزت موسكو حضورها الأمني في المنطقة، بالأخص من خلال انخراطها في مناطق الصراع مثل سوريا وليبيا منذ العام 2015. في المقابل، تبدو الولايات المتحدة أقلّ استعداداً للقيام بالتزامات أمنية إقليمية. فقد تراجعت الثقة بواشنطن كشريك يمكن التعويل عليه في المنطقة في ظلّ تنامي الشكوك بمدى اكتراث الولايات المتحدة بالمخاوف الأمنية لشركائها التقليديين.[6] زد على ذلك، أظهرت الحرب على غزّة حجم التزام الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، حتى لو تسبب بتوتير علاقاتها الإقليمية أو الدولية. ولكن مثل هذا الموقف يخصّ إسرائيل وحدها، ومن المستبعد أن تبدي الولايات المتحدة التزاماً مشابهاً تجاه أيّ دولة إقليمية أخرى.
في غضون ذلك، يتنامى تأثير المصالح الاقتصادية في سياسة تركيا الخارجية،[7] ما تجلّى من خلال الاستخدام المتزايد للغة الاقتصادية في العلاقات التركية الخليجية. فقد وقّعت تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي بياناً مشتركاً في 21 مارس 2024 من أجل إطلاق مفاوضات التجارة الحرّة بينهما بناءً على الشراكة الاقتصادية الموسّعة القائمة أصلاً بين أنقرة وأبوظبي.[8] وقد كرّر عدد من الدول الإقليمية الأخرى هذا النهج الذي يربط ما بين التطلّعات الجيوسياسية والضرورات الاقتصادية، إذ أعلنت السعودية والإمارات والكويت هي الأخرى عن رؤى اقتصادية تنموية وطنية طموحة.[9] في ما خصّ تركيا، تزايدت حدّة الضغوطات الاقتصادية مع تدهور قيمة العملة المحليّة وارتفاع معدّل التضخم إلى 65 في المئة حتى ديسمبر 2023،[10] ما وضع المسألة الاقتصادية في صلب سياسة أنقرة الشرق أوسطية.
إعادة الضبط في الشرق الأوسط في خضم الحرب على غزّة
وتماشياً مع التوجّهات الإقليمية، ركّزت تركيا على التطبيع والتهدئة في سياستها إزاء الدول الخليجية، والشرق الأوسط بشكل عام، بما فيها إسرائيل (قبل 7 أكتوبر). وتأثّرت هذه السياسة بالضرورات الاقتصادية، وتراجع الدور الأمني الأمريكي في المنطقة، والطريق المسدود الذي بلغته الصراعات الإقليمية، والحاجة للتعامل مع واقع إقليمي مستجدّ تراجع فيه زخم العداوات والتحالفات والتوجهات العقائدية السياسية التي كانت سائدة في حقبة الربيع العربي.[11] ويشكّل التعاون الاقتصادي والتواصل الإقليمي الركيزتين الأساسيتين لهذه الإستراتيجية. ففي ظلّ تدهور الأوضاع الاقتصادية في تركيا، باتت تسعى اليوم لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الخليجية من خلال تحسين علاقاتها مع خصومها السابقين.
يبدو أنّ هذه السياسة أتت ثمارها. فقد وقّع أردوغان في خلال جولته الخليجية التي شملت كلّ من السعودية وقطر والإمارات عام 2023 على عدد من الاتفاقيات، منها اتفاقية مع أبوظبي بقيمة 50,7 مليار دولار وحدها.[12] فازت تركيا أيضاً بعدد من العقود مع الرياض، منها صفقة مربحة لتزويد المملكة بطائرات مسيّرة.[13] ومن المتوقّع أن تتواصل سياسة بناء الجسور مع الخصوم السابقين في الشرق الأوسط، ما ستكون له تبعاته على مناطق الصراع. فقد هدأت التوترات في ليبيا وشرق المتوسط وسوريا، كما تراجعت حدّة المنافسة الجيوسياسية بين تركيا والقوى الإقليمية كمصر والإمارات واليونان، على الرغم من أنّ هذه الأزمات لا تزال بعيدة عن الحلّ. ترافق ذلك مع تعزيز الحوار بين أنقرة وخصومها الجيوسياسيين السابقين،[14] على الرغم من تعطّل تقاربها مع إسرائيل عقب الحرب على غزّة.
شكّلت الحرب الإسرائيلية على غزّة والكارثة الإنسانية التي نتجت عنها نقطة تحوّل إقليمية، أثّرت بشدّة في ديناميات التصعيد والتهدئة والتطبيع في المنطقة. فمساعي إسرائيل للتطبيع مع دول الإقليم من دون اعتبار للفلسطينيين أو حتى على حسابهم توقّفت تماماً، على الأقل حتى المستقبل القريب. ففي حين تكرّر السعودية أنّها لم تتخلّ عن فكرة التطبيع، إلّا أنّها تصرّ على أنّ إقامة دولة فلسطينية يجب أن تكون جزءاً لا يتجزّأ من هذه العملية.[15] إلى ذلك، فإنّ كسر الجليد بين أنقرة وتل أبيب وتعاونهما في شرقي المتوسط وجنوب القوقاز أصبح في خبر كان.
ركّزت أنقرة الممتعضة من دعم الغرب غير المحدود لإسرائيل، على الدبلوماسية الإقليمية وسعت لتدويل الصراع لأقصى حدّ ممكن عبر التوجّه إلى القوى غير الغربية والمؤسسات الدولية. وعلى عكس ميل الكثير من الدول الغربية للتعامل أحياناً مع القضية الفلسطينية على أنّها مسـألة عربية حصراً، تعمل أنقرة على بناء رأي عام دولي مؤيّد للحقوق الفلسطينية ومن ضمنها حقّهم بإقامة دولتهم. وقد زار فيدان لهذه الغاية عدداً من العواصم الإقليمية والدولية في بداية الحرب بغية التسويق لفكرة إنشاء نظام ضامن متعدّد الأطراف،[16] تكون فيه تركيا وعدد من الدول العربية والهيئات الدولية أطرافاً ضامنة للتسوية. وكانت تركيا أيضاً أحد الداعمين الرئيسيّين للقمّة العربية الإسلامية التي عُقدت في نوفمبر 2023 في الرياض والتي انبثقت عنها لجنة من سبع دول مكلّفة بقيادة الجهود الدولية الهادفة لوقف إطلاق النار في غزّة وإنهاء الحرب.[17]
على امتداد هذه العملية، استمرّت تركيا في دعم جهود الدول العربية الوازنة مثل قطر ومصر والسعودية إلى حدّ ما والتكامل معها، فلم تطغَ عليها أو تنافسها. يجوز القول إذاً إنّ الحرب عزّزت التطبيع بين تركيا والدول الخليجية، في انقلاب على الديناميات التي كانت سائدة أبّان الربيع العربي، حين كانت أنقرة تخاطب تطلّعات الشارع العربي، لا النخب العربية، ما تسبّب بأزمات كبرى في علاقاتها مع بعض الدول. ولكن اليوم، يبدو أنّ تركيا عادت إلى سياستها الإقليمية التي كانت تنتهجها ما قبل الربيع العربي، والقائمة على الموازنة ما بين استعطاف الشعوب العربية، وبناء علاقات ودّية مع الحكّام من أجل تعزيز التعاون الإقليمي.
لقد أدّت الحرب على غزّة كذلك إلى تخفيف حدّة التوتّر بين تركيا وإيران، على الأقلّ في الوقت الراهن. فقبل 7 أكتوبر، كانت إيران تنظر بريبة إلى التعاون الثلاثي المحتمل بين تركيا وأذربيجان وإسرائيل في جنوب القوقاز. إلّا أنّ هذا التعاون الثلاثي ذهب أدراج الرياح على الأقل حتى المستقبل القريب، على خلفية الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة. ومنذ بداية الحرب، تبادل مسؤولون أتراك وإيرانيون عدداً من الزيارات الرسمية،[18] ومن المتوقّع أن يتواصل هذا التقارب فيما يهيمن الوضع في غزّة على الأجندات الإقليمية والدولية. ولكن مع انحسار الحرب، قد تعود الديناميات التنافسية لتسود العلاقات التركية الإيرانية، نظراً لاتساع الرقعة الجغرافية لهذه المنافسة لتمتدّ إلى آسيا الوسطى وجنوب القوقاز[19] بالإضافة إلى العراق وسوريا، حيث تعتبر طهران أنّ النظام الإقليمي الناشئ في جنوب القوقاز يشكّل تهديداً لمصالحها. وتتفاقم هذه المخاوف الإيرانية مع تنامي الأهمية التي توليها تركيا “للعالم التركي”، ما تعتبره إيران تحديّاً جيوسياسياً ووطنياً نظراً للمكوّن الأذري الوازن في إيران. إلى ذلك، دعمت أنقرة مشاريع الترابط الإقليمية، مثل الممرّ الأوسط الذي يربط الصين بأوروبا عبر آسيا الوسطى وبحر قزوين وجنوب القوقاز (أذربيجان وجورجيا) وتركيا، ما أثار حفيظة طهران.
أخيراً، على الرغم من الأهمية المتزايدة للعوامل الاقتصادية في رسم معالم السياسة الخارجية التركية، فإنّ الهواجس الأمنية ستظلّ حاضرة في سياستها تجاه دول الجوار، بالأخص سوريا والعراق. فستواصل تركيا عملياتها العسكرية ضدّ حزب العمّال الكردستاني، بالأخص في كردستان العراق. بالفعل، لقد أجرت أنقرة محادثات متعدّدة في الأشهر الماضية مع بغداد وأربيل تمحورت حول اتّخاذ إجراءات مشتركة ضدّ الحزب. والتقى وزيرا الخارجية والدفاع التركيان ورئيس الاستخبارات بنظرائهم العراقيين في بغداد في وقت سابق هذا العام،[20] وقد أسفرت الاجتماعات عن تصنيف العراق لحزب العمّال الكردستاني كتنظيم محظور.[21] وفي حين تراجعت حدّة الهجمات التي تشنّها تركيا على المجموعات المؤيّدة لحزب العمّال الكردستاني في سوريا،[22] سواء مباشرةً أو من خلال مجموعات المعارضة السورية، من المستبعد أن تتوقف هذه العمليات نهائياً. بالتالي، احتمالات التصعيد والتأزم ستظلّ واردة بشدّة على الجبهتين السورية والعراقية.
قلب الموازين في العلاقات التركية الروسية
دخلت العلاقات التركية الروسية مرحلة جديدة عام 2016 مدفوعة بالضرورات الجيوسياسة والاستياء المشترك من الغرب، وارتكزت أيضاً على التقارب الشخصي بين أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.[23] وقد تميّزت هذه المرحلة بثلاث محطّات رئيسية. أولاً، انفتحت تركيا على التعاون الدفاعي مع موسكو، فاشترت منظومة الصواريخ الروسية “أس -400” ما دفع بالولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على أنقرة انطلاقاً من قانون “مواجهة خصوم أمريكا بواسطة العقوبات”، واستبعدت تركيا عن برامج مقاتلات “أف -35” عام 2019.[24]
ثانياً، تعاونت أنقرة وموسكو عن قرب لإدارة الصراعات الإقليمية، من سوريا وليبيا إلى ناغورني قره باغ.[25] وقد أدّت الأزمة السورية دوراً محورياً في رسم مسار العلاقة التركية السورية، ففي حين تسبّبت الأزمة بشرخ بين أنقرة وواشنطن بسبب دعم الأخيرة لوحدات حماية الشعب الكردية التابعة لحزب العمّال الكردستاني في سوريا، إلّا أنّها قرّبت بين تركيا وروسيا.[26] وفي بداية عام 2017، أطلقت أنقرة وموسكو وطهران منصّة آستانا للحلّ السياسي في سوريا التي همّشت دور عملية جنيف بقيادة الأمم المتحدة.
ثالثاً، تعاونت أنقرة وموسكو في مجالات حسّاسة وإستراتيجية سينجم عنها ترابط على المدى الطويل. مثلاً، تتولّى شركة “روس أتوم” الروسية بناء مفاعل “أكويو” النووي الأوّل من نوعه في تركيا[27] الذي يُتوقع أن يُنتج عند اكتماله حوالي 10 في المئة من الكهرباء المستهلكة في البلاد، ما يزيد من اعتماد تركيا على روسيا في وقت تسعى دول أخرى إلى خفض اعتمادها على الطاقة الروسية.[28] وستتوّلى “روس آتوم” تشغيل المفاعل أيضاً لمدة 25 عاماً، ما يعني أنّه سيكون مبنياً ومشغّلاً من قبل روسيا.[29]
ولكن من المستبعد أن تستمرّ أنقرة بالتعاون الدفاعي مع موسكو في المستقبل، وستتجنّب شراء المزيد من الأسلحة المتطورّة منها، نظراً للتكلفة الباهظة لنظام “أس-400” على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية. وقد تحجم تركيا عن المزيد من التعاون مع روسيا في مجالات حسّاسة وإستراتيجية مثل الطاقة النووية، ولكنّهما ستواصلان التعاون في القضايا الجيوسياسية، مع أنّ حجم هذا التعاون قد يتراجع في مناطق الصراع في الشرق الأوسط حين تخبو حدّة الصراعات في دولٍ مثل سوريا وليبيا.
بعيداً عن الشرق الأوسط، يُتوقع أن تبقي الدولتان منخرطتين في جنوب القوقاز والبحر الأسود ودول الاتحاد السوفياتي السابقة بشكل عام. إلى ذلك، عملت روسيا على كبح انجرار تركيا خلف الموقف الغربي تجاهها، فمهّدت الطريق لأنقرة لتأدية أدوار مختلفة في الأزمة الأوكرانية. على سبيل المثال، تمّت صفقة تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وروسيا في أبريل 2022 بوساطة تركية،[30] حيث جرت عملية تبادل الطيّار الروسي قسطنطين ياروشينكو بالعنصر السابق في البحرية الأمريكية تريفور ريد في تركيا.[31] واستضافت منظمة الاستخبارات الوطنية التركية في وقت لاحق ذلك العام رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بيل بيرنز ورئيس المخابرات الخارجية الروسية سيرغي نارشكين في اجتماع في أنقرة.[32] أدّت تركيا أيضاً دوراً أساسياً إلى جانب الأمم المتحدة في التوصّل لاتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا التي كانت حاسمة في تخفيف أزمة الغذاء العالمية آنذاك. وبعد انسحاب روسيا من الاتفاقية من جانب واحد في يوليو 2023،[33] بذلت أنقرة جهوداً دبلوماسية حثيثة لإعادتها إلى طاولة المفاوضات، وأعدّت رزمة مقترحات جديدة بالتعاون مع الأمم المتحدة لإحياء الاتفاقية، ولكن محاولاتها لم تؤتِ ثمارها.[34] ويمكن لعلاقات أنقرة الوثيقة مع كلّ من موسكو وكييف أن تمكّنها من لعب أدوار متعدّدة.
إلّا أنّ تزايد أهميّة تصوّر “العالم التركي” في السياسة الخارجية التركية قد يؤجّج التوترات مع موسكو، فالبقعة الجغرافية التي تعتبرها أنقرة جزءاً من “العالم التركي” هي الفناء الخلفي لموسكو ومنطقة نفوذها في حقبة ما بعد الاتحاد السوفياتي، ما من شأنه أن يؤجّج الديناميات التنافسية في العلاقات التركية الروسية. مع ذلك، ستسعى أنقرة للحفاظ على علاقات طيبة مع موسكو على الرغم من هذه التوترات.
العلاقات التركية الغربية تتحسّن، لكن الأزمات القائمة تبقى عالقة
في المقابل، من المرجّح أن تتحسّن العلاقات التركية الغربية. فاحترافية صانعي القرار الجدد في السياسة الخارجية والأمنية التركية، إلى جانب حلّ أزمة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي وموافقة الولايات المتحدة على بيع مقاتلات “أف-16” إلى تركيا،[35] كلّها تنبئ بتقارب تركي غربي. يبرز أيضاً خفض منسوب التوتر في شرقي المتوسط وما صاحبه من تقارب تركي- يوناني. فقد أظهرت كلّ من أنقرة وأثينا عزمهما الواضح على التهدئة، حيث استبدلت الخطابات المتشنجة بلغة جديدة تؤكّد على حسن الجوار[36] والتعاون، من ضمنها كان اقتراح أردوغان التعاون النووي بين البلدين.[37] ونظراً لأهميّة شرقي المتوسط بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، سينعكس انخفاض التوتر في المنطقة إيجاباً على علاقات تركيا مع الاتحاد.[38]
مع ذلك، لا يعني هذا التحسّن الذي طرأ على العلاقات التركية الغربية أنّ المشكلات والتحدّيات الجوهرية ستتغيّر أو تتلاشى. فالفرق واضح بين قراءة تركيا من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، للسياسة الدولية وتنافس القوى العظمى. إذ ترحّب أنقرة بتعدّد مراكز القوى الذي تنظر إليه كتطوّر إيجابي من شأنه أن يمنحها هامش مناورة أوسع في علاقاتها مع الغرب. ويتجلّى هذا الفرق في اختلاف وجهات النظر بين البلدين حيال طبيعة التهديد على الساحة السورية. زد على ذلك أنّ صعود الصين لا يقلق تركيا، على عكس الولايات المتحدة.
علاوة على ذلك، ينذر انعدام الرؤية الجيوسياسية الأوروبية المترافق مع انحدار الديموقراطية في تركيا بتعميق تعثّر انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. ولكن هذا لا ينفي وجود أطر تعاون أخرى بين أنقرة وبروكسيل، مثل قضايا الهجرة والتحوّل في مجال الطاقة، وبعض القضايا الجيوسياسية، مثل الأمن في الجوار الأوروبي الجنوبي والشرقي (ولو بشكل محدود)، إلّا أنّ العقبات الأساسية والخلافات التي تشوب العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ستستمرّ على الأرجح في الحدّ من أفق التعاون.
دور وزارة الخارجية
إلى جانب التغيّرات التي طرأت على السياسة الخارجية في كلّ منطقة على حدة، من المتوقّع أن تضطلع وزارة الخارجية بدور أبرز في تحديد أولويّات السياسة الخارجية التركية وإستراتيجياتها، حيث ستطال التغييرات المرتقبة الجوانب المؤسّساتية والأسلوبية والعقائدية. في المقام الأوّل، يتوقّع أن تعزّز وزارة الخارجية مكانتها في عملية صنع القرار. ففي السنوات الماضية، كانت السياسة الخارجية تُحدّد من قبل الرئاسة ووزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات والجيش معاً، فيما تأثير وزارة الخارجية بحدّ ذاتها كان متواضعاً. ولكن يُرجّح أن ترتقي وزارة الخارجية بدورها تحت قيادة فيدان المتنفّذ والذي يحظى بثقة الرئيس أردوغان. إلى ذلك، يُنتظر أن تتبنّى السياسة الخارجية التركية لغةً وأسلوباً يتّسمان بالمزيد من الاحترافية الدبلوماسية والمؤسساتية.[39]
أخيراً، إذا ما سعت أنقرة فعلاً إلى تبنّي مفهوم “العالم التركي” في سياستها الخارجية ومنحه المزيد من الأهمية، قد يهدّد ذلك بتأجيج التوتّرات في علاقاتها مع إيران وروسيا والصين. فروسيا تعتبر الرقعة الجغرافية التي يمتد فيها “العالم التركي”،[40] سواء في آسيا الوسطى أو جنوب القوقاز، باحتها الخلفية ومنطقة نفوذها، وأيضاً خاصرتها الجيوسياسة الرخوة. وفي ظلّ التنافس المحتدم بين الغرب وروسيا والصين، يمكن لهذا المسعى التركي أن يؤجّج التوترات مع موسكو، ويقود بالتالي إلى المزيد من التقارب التركي- الغربي ضمن هذه البقعة الجغرافية.
الخاتمة
ستستمرّ تركيا بتكييف سياستها الخارجية مع التغيّرات الإقليمية والدولية، فيما تتفاقم احتياجاتها والأوضاع الاقتصادية. ولكن من المستبعد أن يطرأ أي تغيير كبير على الإطار العام لسياستها الخارجية في المستقبل القريب، حيث ستستمر في التركيز على تعزيز استقلالية البلاد ومكانتها الدولية.
الهوامش