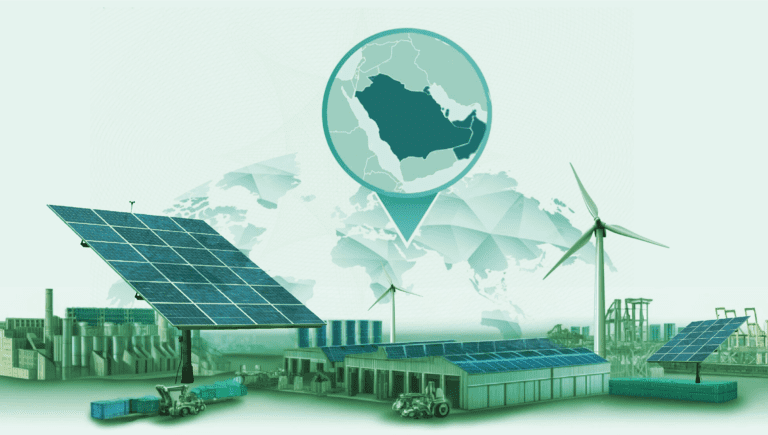الوساطة المحلّية:
جسر السلام في نزاعات اليمن وليبيا والسودان
موجز قضية، ديسمبر 2025
النقاط الرئيسيّة
الوساطة المحلية شرطٌ لازم لا بديل عن المسارات الدولية : ا تُغني الوساطة المحلية عن الجهود الدولية، لكنها تُمثّل عنصرًا أساسيًا لنجاحها في سياقات انهيار الدولة وتعدّد مراكز السلطة، كما في اليمن وليبيا والسودان. وتستمدّ فاعليتها من شرعية اجتماعية تتيح تحقيق نتائج ميدانية سريعة وعملية، غالبًا ما تعجز المسارات الرسمية عن إنجازها.
الفعالية مستندة إلى الشرعية الاجتماعية لكنها مقيّدة بهشاشة بنيوية: تعتمد الوساطة المحلية على شبكات اجتماعية متجذّرة—قبلية ودينية وأهلية—وآليات عرفية مرنة تُسهم في احتواء العنف رغم ضعف المؤسسات. غير أنّ نتائجها تظلّ جزئية وهشّة بفعل المخاطر الأمنية، وغياب الضمانات، وتقلّب موازين القوى.
نماذج وساطة متباينة ضمن قيود متشابهة: تختلف أشكال الوساطة المحلية بين اليمن وليبيا والسودان، من التحكيم القبلي إلى لجان المصالحة وهياكل الجودية، لكنها تواجه قيودًا بنيوية متقاربة. وفيما تسهم النساء ومنظمات المجتمع المدني بشكل متزايد في تعزيز الشرعية، تبقى مشاركتهما محدودة ومهمّشة على المستوى المؤسسي.
السلام المستدام رهين دعمٍ حذر وإدماج وطني: يتطلّب تعزيز الوساطة المحلية توفير التمويل والتدريب والحماية دون تسييسها أو تحويلها إلى بديل عن بناء الدولة. كما أنّ إدماج مخرجاتها في المسارات الوطنية يفتح المجال أمام سلامٍ تدريجي أكثر رسوخًا، مقارنةً بالاعتماد على اتفاقات شاملة هشّة.
تواجه كل من اليمن وليبيا والسودان نزاعات مسلّحة أدّت إلى انهيار مؤسّسات الدولة وتشظّي السلطة المركزية بين فاعلين متعدّدين مدعومين خارجياً. وقد اتّضح خلال العقد الماضي أنّ الجهود الدولية وحدها غير كافية لحلّ النزاعات الممتدّة وتحقيق سلام شامل في هذه الدول، وهنا تبرز الوساطة المحلّية كآليّة حيوية لإدارة الصراعات الداخلية وحلّها على المستويات القاعدية. ففي بيئات تتّسم بطول أمد النزاع وتعدّد القوى المسلّحة وتفتُّت السلطة، يُنظر إلى الوساطة المحلّية كبديل فاعل أو مكمّل للجهود الدولية والوطنية التي تواجه صعوبات في معالجة جذور الصراع بما يضمن قبول جميع الأطراف المتنازعة.
في اليمن، تعثّرت مفاوضات السلام الأُممية مراراً أمام تعنّت القوى المتحاربة وتضارب أجنداتها المحلّية والإقليمية، بينما استطاعت مبادرات محلّية، كوساطات زعماء القبائل والشخصيات المجتمعية، تحقيق اختراقات محدودة وملموسة على الأرض، مثل فتح طرقات مُغلقة، وتبادل جثامين وأسرى، وإبرام هُدَن إنسانية مؤقتة. وفي السودان، ساهمت الوساطة المحلّية -القائمة على الإدارة الأهلية- التي تُعرف محلّياً أحياناً بالجُودية1 في تعزيز التعايش السلمي، ومنع توسّع النزاعات إلى مواجهات مسلّحة واسعة وفق الأعراف الاجتماعية. أمّا في ليبيا، فقد أدّت الوساطة المحلّية ممثّلة بلجان الصلح إلى احتواء العديد من الاشتباكات المسلّحة ومنعها من التصعيد، فضلاً عن فتح الطرق المُغلقة بين المدن والمناطق، وتبادل الجثامين والأسرى والمعتقلين، لكنّ عملها غالباً ما أتى مُكمّلاً للهُدَن التي عُقدت أساساً بين قادة الميليشيات المسلّحة والكتائب العسكرية. ومع أنّ هذه الخطوات صغيرة في حجمها، فإنّ أثرها كبير في تخفيف المعاناة وإنقاذ الأرواح ضمن واقع انسداد الأفق السياسي.
تختلف الوساطة المحلّية عن نظيرتها الدولية في جوانب متعدّدة؛ فالأولى تعتمد على فاعلين من داخل المجتمع المتأثّر بالنزاع، وبالاستناد إلى الأعراف والقيم المحلّية، وغالباً ما تكون اتفاقاتها شفهية ومدعومة بالتقاليد العرفية، وتهدف إلى احتواء التصعيد أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل النزاع. أمّا الوساطة الدولية فتعتمد على طرف ثالث أجنبي، وغالباً ما تكون محدودة بإطار زمني مُحدّد، وتسعى لإيجاد حلول تقنية مستقاة من الدبلوماسية والقوانين والأعراف الدولية، وهو ما يجعلها في كثير من الأحيان موضع شكّ من أطراف الصراع المحلية، أو داعميها الخارجيين المتنافسين في حال هدّدت مصالحهم.
عملياً، تبدأ الوساطة بجمع الأطراف المتنازعة أو التفاوض مع كل طرف على حدة، ثم الاستماع إلى سرديات الأطراف الأخرى وتقصّي الحقائق، وبعد ذلك تُطرَح حلول توافقية مثل دفع التعويضات والديات في حالة القتل، أو تحديد مسارات الرعاية، أو وقف القتال مؤقتاً ريثما يبتّ قانون الدولة الرسمي في النزاع. وغالباً ما يُعلَن الاتفاق أمام المجتمع، وأحيانا يُدوَّن، الأمر الذي يمنحه قوّة مُلزِمة للأطراف كافة. وهنا تقوم الإدارة الأهلية أو اللجان المحلّية بمتابعة التنفيذ وفرض الغرامات على مَن يخرق الاتفاق، وهو ما يجعل هذه الآليّة فاعلة على المدى القصير في الحدّ من العنف أو التخفيف من آثاره الإنسانية. غير أنّ غياب إطار مؤسّساتي يحمي هذه الحلول يجعلها هشّة عند تغيّر موازين القوى، وتوسّع دائرة النزاع، بحيث يصبح التفكير في سبل دمجها ضمن مسارات أوسع للسلام الوطني والإقليمي أمراً ضرورياً.
وعلى الرغم من اختلاف السياقات، فإنّ هذا الموجز يحلّل، عبر المقارنة، تجارب الوساطة المحلّية في اليمن وليبيا والسودان، مستكشفاً أوجه التشابه والاختلاف في الآليّات والفاعلين والنتائج. وتحاجج الورقة في أنّه عندما تتراجع الدولة، تتقدّم الحلول المحلّية المعتمدة على آليّات الوساطة العرفية والقَبَلية والدينية لملء الفراغ الناجم عن غياب السلطة المركزية وضعفها. ونهدف من خلال تحليل التجارب الثلاث إلى استخلاص دروس عملية لصنّاع السياسات بشأن كيفية دعم دور الوساطة المحلّية وتفعيله وضمان استدامته جنباً إلى جنب مع المسارات الرسمية لإنهاء النزاعات.
خلفية النزاعات والوساطات المحلّية
تسببّت الحروب في ليبيا واليمن والسودان بدمار بشري واقتصادي هائل. ففي ليبيا، بات نحو 823 ألف شخص الآن، بينهم ما يقرب من ربع مليون طفل، بحاجة إلى مساعدة إنسانية،2 مع تضرّر أكثر من 147 ألف نازح، و900 ألف مهاجر تقريباً.3 وقد كلّف الصراع الاقتصاد الليبي خسائر تُقدَّر بنحو 576 مليار دولار أمريكي.4 أمّا في اليمن، فيحتاج ما يقرب من 19,5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في سنة 2025،5 بينما انهار نصيب الفرد من الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي بنحو 58 في المئة منذ سنة 2015؛6 وقد تم فعلاً تقييم الأضرار في 16 مدينة رئيسية بما يتراوح بين 6,8 و8,3 مليارات دولار أمريكي.7 علاوة على هذين البلدَين، يواجه السودان الآن أكبر أزمة نزوح في العالم، إذ شرّد الصراع 11,7 مليون شخص تقريباً – أكثر من 4 ملايين منهم فرّوا إلى دول مجاورة8 – في حين انكمش الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 29 في المئة في العام 2023، و13 في المئة أُخرى في سنة 2024،9 كما انخفض إنتاج النفط بأكثر من النصف، ومن المتوقّع أن تصل تكلفة إعادة الإعمار إلى تريليون دولار أمريكي.10
اليمن: إرث قَبَليّ عميق الجذور
اندلعت الحرب الأهلية اليمنية الأخيرة في أواخر سنة 2014، وتصاعدت جرّاء تدخّل إقليمي عبر ما يُعرف بعملية “عاصفة الحزم” في سنة 2015، وهو ما أدى إلى انهيار مؤسّسات الدولة، وانقسام البلد بين سلطات أمر واقع متعددة. وأوجد هذا المشهد فراغاً أمنياً وقضائياً دفع السكان إلى الركون إلى الأعراف القَبَلية والشخصيات الاجتماعية للحفاظ على الحدّ الأدنى من النظام. فاليمن يمتلك تقليداً عريقاً في حلّ النزاعات عبر القبائل؛ إذ حتى قبل الحرب كان اليمنيون يفضّلون حلّ ما يتراوح بين 80 و90 في المئة من القضايا ودياً عبر الأعراف بدلاً من المحاكم.11 وخلال الصراع الحالي، استمرّت القبائل اليمنية ووجهاء المجتمع في أداء هذا الدور، بل اتسعت أهميته؛ فعندما يتعذّر عقد أي اتفاق سلام رسمي شامل، تنشط على الأرض عشرات الوساطات المحلّية التي نجحت في تحييد بعض المناطق عن القتال، وإبرام اتّفاقات تهدئة محدودة كانت آثارها إيجابية على المدنيين. فعلى سبيل المثال، تدخّل الوسطاء المحلّيون لتنسيق تبادل الأسرى والجثامين بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة أنصار الله (الحوثيون) خارج إطار التفاوض الرسمي، الأمر الذي أثمر عن تحرير المئات من الأسرى عبر صفقات تبادل محلّية. وهكذا برزت الوساطة القَبَلية والمجتمعية في اليمن كعامل استقرار نسبيّ يحدّ من تدهور الأوضاع الإنسانية، في وقت بلغ النزاع فيه مستوى الحرب الشاملة على الصعيد الوطني.12
شبكة معقّدة من الوسطاء
تستند الوساطة المحلية في اليمن إلى شبكة مجتمعية متجذّرة ترتكز على القبيلة بالدرجة الأولى، فعندما يحدث نزاع بين جماعتَين (أكانتا قبيلتَين أم فصيلَين مسلّحين)، يبادر شيوخ قَبَليون من ذوي الاحترام لدى الطرفين إلى التدخّل. وهنا يستخدم الوسيط اليمني أدوات العُرف مثل التحكيم القَبَلي والعَيب القَبَلي للضغط نحو التسوية. فمثلاً إذا اندلع ثأر بين قبيلتَين، قد يرسل الشيخ “مبعوثاً” من طرفه يحمل بندقيته بشكل مقلوب كإشارة إلى طلب الأمان وبدء الصلح. تجتمع الأطراف في لقاء عُرفي يسمى التحكيم، وتتعهّد بوقف القتال وتسليم الجناة، فيتولّى الشيخ تقدير الدِّيَة والتعويضات وفق الأعراف، ويطلب من الطرفين قَسَم اليمين على الالتزام.13 وهكذا كثيراً ما تُحل القضايا من دون اللجوء إلى الدولة.
برزت في الحرب الحالية، إلى جانب الشيوخ، شخصيات مجتمعية مدنية دخلت على خطّ الوساطة في قضايا معيّنة؛ مثل الناشط هادي جمعان الذي تخصّص في التوسّط لتبادل الأسرى وانتشال الجثث بجهود فردية؛14 ورابطة أمهات المختطفين التي ضغطت لكشف مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم.15 وقد أدّت المرأة اليمنية دوراً خفيّاً لكنّه مؤثر، عبر استثمار مكانتها “المصونة” قَبَليّاً للتفاوض؛ فكثيراً ما اقتحمت أمّهات المعتقلين وزوجاتهم الساحات وبعض المقارّ الحكومية بلا خوف للمطالبة بالإفراج عن ذويهم، أو ربما تستخدم كبيرات السن أساليب رمزية (كإلقاء خمارهن) لإجبارهم على الصلح.16 ولا ننسى أيضاً دور الوجهاء الدينيين، فالأئمّة والدعاة المحلّيون كثيراً ما يذكّرون المتخاصمين بواجب حقن الدماء. وهذا المزيج من الأدوات التقليدية والدينية منح الوساطات المحلّية قوّة إقناع مؤثّرة إلى حد ما داخل المجتمع اليمني.
ليبيا: تنوّع آليّات الوساطة بين الشرق والغرب
بعد سقوط نظام معمر القذّافي في سنة 2011، دخلت ليبيا في دوامة من النزاعات المسلّحة. وبينما انشغل المجتمع الدولي بخطط انتقال سياسي وانتخابات وطنية، ازدهرت الوساطات المحلّية ميدانياً، كابحة إلى حد ما انزلاق البلد إلى الفوضى التامة. وفي ظلّ انهيار المؤسّسات الأمنية، اضطر العديد من المجتمعات المحلية إلى الاعتماد على الأعراف القَبَلية ولجان الصلح الأهلية لرأب الصدع وتوفير بعض الأمن المجتمعي. فقد كان لدى ليبيا تاريخياً تقاليد قَبَلية لحلّ الخلافات الاجتماعية (وخصوصاً في المناطق الريفية) مثل “الميعاد” و”جبر الخواطر”، وهي عبارة عن التقاء مشايخ قَبَليين لتسوية الخلافات ونشر الوئام في حال وجود نزاع مجتمعي بشأن قضية ما. وبعد سنة 2011، تشكّلت كيانات جديدة كالمجالس البلدية ومنظّمات أهلية ومدنية أدّت دور الوسيط في فضّ النزاعات.17
شهدت الفترة بين 2011 و2018 إبرام ما لا يقل عن ثمانية اتفاقات مصالحة بين قوى اجتماعية محلّية، مرتبطة أو متحالفة مع ميليشيات مسلّحة متعدّدة الأهداف والولاءات، وتنحدر من عدة مناطق ومدن ليبية.18 وكان من أبرز هذه الاتفاقات اتفاق مصراتة وتاورغاء (2016–2018) الذي أفضى إلى عودة آلاف النازحين من أهالي تاورغاء إلى مدينتهم بعد سبعة أعوام من التهجير القسري. وقد وصف مسؤول أُممي رفيع المستوى هذه الحلول بأنها “أفضل ما حدث في ليبيا منذ الثورة”.19 كذلك أسفرت وساطات قادَتْها مجالس قَبَلية في سبها في جنوب ليبيا عن عقد صلح بين أطراف مسلّحة تنحدر من قبيلتَي التبو والطوارق في سنة 2015، وذلك بعد جولات اقتتال دامية. وبينما فشلت الحكومات المتعاقبة في توحيد المؤسّسات الأمنية وإعادة بنائها، فإنّ هذه المصالحات المحلّية أدّت دوراً مهماً في احتواء النزاعات الداخلية ومنعها من الامتداد، ومع ذلك، كثيراً ما ظلّ تأثيرها محدوداً، ونجاحها جغرافياً وزمنياً متفاوتاً، بسبب غياب مظلّة وطنية جامعة لها.
تنوّع الفاعلين بين التاريخي والمعاصر
تتميّز الوساطة المحلّية في ليبيا بأنها غالباً منظّمة على مستوى المجموعات كـ”لجان المصالحة” التي هي لجان مشتركة تضمّ أعياناً وشيوخاً قَبَليين ورجال دين، وأعضاء مجالس محلّية وناشطين مدنيين. لجان الوساطة هذه تتشكّل عادة جرّاء اندلاع نزاع مسلّح واسع النطاق، أو نتيجة اقتتال داخلي ضمن نطاق ضيّق، وتشمل في معظم الأحيان ممثلين فعليّين، أو شكليّين، عن الأطراف المعنية بالصراع، إلى جانب أعيان وشخصيات “محايدة” غير محسوبة على أيّ من أطراف النزاع.
وتشكّل اتفاقات وقف إطلاق النار في غرب ليبيا خلال الفترة 2014-2015 بين ميليشيات مصراتة و ورشفانة، ومصراتة والزنتان، والزنتان وغريان وزوارة والزاوية، علاوة على البلدات المجاورة في جبل نفوسة، مثالاً مهماً للدور الذي قامت به لجان الوساطة في احتواء الصراع وخفض التصعيد في غرب ليبيا. ففي معظم الحالات السابقة، دُعمت اتفاقات وقف إطلاق النار من خلال تدابير بناء الثقة التي أقرّتها مواثيق الصلح التي وقّعتها اللجان الممثّلة لأطراف الصراع، وتشمل غالباً: وقف إطلاق النار؛ وتبادل الأسرى؛ وانسحاب المسلّحين من مناطق التّماس؛ وفتح الطرق المُغلقة؛ وتعويضات للضحايا؛ وعودة النازحين… إلخ. وقد ساهم هذا النهج بفاعليّة في تهيئة حالة سلام عامّة في غرب ليبيا مهّدت الطريق أمام توقيع اتفاق السلام الليبي المعروف باتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015. 20
من جهة أُخرى، انخرطت بعثة الأُمم المتحدة في ليبيا في دعم هذه الوساطات المحلية بشكل متنامٍ، فبدأت بعد سنة 2015 تعتمد جزئياً على الوسطاء المحلّيين، فتقدّم لهم الخبرة الفنية، أو حتى تشارك عبر مراقبين لها في لجان المصالحة الوطنية كي تمنحها زخماً دولياً. وثمّة آليّة أُخرى مهمّة في ليبيا هي المجالس الاجتماعية للقبائل التي أُعيد تفعيلها في بعض المدن والمناطق بعد انتفاضة 2011؛ مثل المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة الذي تولّى إدارة شؤون مدينة بني وليد، باستقلالية كبيرة عن مراكز السلطة الرئيسية في شرق ليبيا وغربها، كما ساهم في فضّ صراعات بعض القوى المسلّحة في المدينة مع غيرها باستخدام الإرث التاريخي للأعراف المحلّية والقَبَلية.21 وفي المحصلة، تحوّلت آليّات الوساطة المحلّية في ليبيا من اجتماعات تقليدية تُعقد في الصالونات إلى مؤتمرات مصالحة وطنية برعاية حكومية ودولية سَعَت في معظمها لخفض تصعيد النزاع محلّياً ومنع انتشاره.
السودان: إرث تاريخي ودور متجدّد
شهد السودان لعقود عدة نزاعات، امتدت من الصراعات السلطوية إلى النزاعات القَبَلية والمناطقية في دارفور وكردفان والنيل الأزرق، على طول شرق البلاد وجنوبها. وقد غذّى هذا الواقع تنوّع الأعراق والقبائل وتباين أنماط المعيشة، كما شكّلت الأرض والمياه والموارد محوراً رئيسياً لهذه النزاعات، وخصوصاً في ظلّ ضعف مؤسّسات الدولة، وغياب آليّات عدالة فاعلة في المناطق البعيدة. والنتيجة كانت مشهداً متكرراً من الصراعات التي يصعب احتواؤها.
أمّا أكثر حلقات هذا المسار حداثة فتجسّد في الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وحلفائهم، وما نجم عنها من انهيار شبه كامل لمؤسّسات الدولة ومنظومات العدالة الرسمية. وفي ظلّ هذا الفراغ، برزت مبادرات وساطة محلّية قادها الأعيان والحكماء ورجالات الإدارات الأهلية (الأجاويد)، مستندة إلى إرث طويل من مؤتمرات الصلح الأهلي، لتؤدي دوراً في احتواء النزاع والحدّ من تداعياته الإنسانية. وعلى الرغم من تعثّر المسارات الوطنية، فإنّ هذه المبادرات تمكّنت من تحقيق اختراقات إنسانية ملموسة، مثل فتح ممرات للإجلاء والإغاثة، وإفساح المجال لعمليات الدفن، وعقد هُدَن قصيرة، وتنسيق لصفقات تبادل الأسرى والجثامين بين الأطراف المتحاربة، وهي وقائع وثّقتها تقارير إعلامية وحقوقية مستقلة.22 وقد ساهم هذا الدور في منع انزلاق البلد إلى حرب أهلية شاملة، ولو على نحو محدود ومؤقت.
أحد أبرز الأمثلة وقع في مدينة الفاشر (عاصمة شمال دارفور) في أواخر سنة 2023، عندما كان الدعم السريع على وشك خوض معركة كبرى للسيطرة على المدينة وضمّها إلى سائر ولايات دارفور.23 عندها تشكّلت لجنة وساطة محلّية من أعيان الفاشر شملت زعماء قبائل وإداريّين ومهنيّين وممثّلين عن روابط النساء والشباب. ونجحت اللجنة في التوصّل إلى وقف إطلاق نار، الأمر الذي وفّر متنفّساً للسكان، لكنه سرعان ما انهار، لتتعرّض المدينة لاحقاً لانتهاكات جسيمة. ومع ذلك، عكس هذا المثال قدرة المجتمع المحلّي على التدخّل في لحظات حرجة لدرء الكارثة، ولو على قدر محدود.
وقد انتشرت جهود مشابهة في ولايات دارفور الأُخرى وأجزاء من كردفان، حيث سعى الوجهاء المحلّيون لاحتواء العنف وحماية المدنيين وسط غياب أي سلطة مركزية فاعلة. وهكذا برزت الجُودية السودانية قديماً وحديثاً على الرغم من تعرّضها للاتّهام بالتسييس تاريخياً، فهي تظلّ آليّة محلّية ساهمت ولا تزال تساهم في حل النزاعات ومنع تفاقمها مناطقياً، وإن ظلّت عاجزة عن معالجة جذور الصراع البُنيوية للدولة (تفتّت السلطة؛ اقتصاد الحرب؛ أزمات الأرض والموارد).
مجموعة فاعلين في المشهد
تُعتبر لجان الوساطة المحلّية في السودان إحدى الآليّات التي حافظت على الحدّ الأدنى من التماسك المجتمعي في ظلّ تواتر النزاعات وضعف مؤسّسات الدولة، ذلك بأنها ليست مجرد ممارسة تقليدية فقط، بل هي أيضاً نتاج تراكم تاريخي من الأعراف والسلطات المجتمعية التي تجسّدت في الإدارة الأهلية ولجان الحكماء والأجاويد. وتتكّون هذه اللجان أو المبادرات من أعيان القبائل وزعماء الإدارة الأهلية من نظّار وعمداء ومشايخ (يقابله الشرتاي، والدمنقاوي، والفرشة، والسلطان عند بعض القبائل الأُخرى)، وتشارك فيها أحياناً شخصيات مجتمعية ودينية وقانونية، وممثّلون عن النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني. فمثلاً ساهمت واحدة من هذه المبادرات في إعادة التواصل بين قبيلتَي المساليت والفلاتة بعد قطيعة دامت 20 عاماً في جنوب دارفور، من خلال لقاءات وتبادل زيارات ونشاطات مجتمعية ورياضية انطلقت من رغبة محلّية، وبعيداً عن التدخّلات السياسية. 24 وهذا التنوّع الذي تتميّز به هذه اللجان يمنحها سلطة واسعة لأنها تعكس البُنية الاجتماعية والثقة الشعبية في مناطق النزاع، وتتيح لها مساحة للتأثير والقبول من مختلف الأطراف.25
وتعمل هذه الوساطات على تهدئة التوتّر ووقف الاعتداءات من خلال الحوار المباشر والتفاوض غير الرسمي، كما تفتح قنوات تواصل بين الجماعات المتصارعة. وفي حالات متعددة مارست دوراً يتجاوز الوساطة التقليدية، إذ تولّت مهمّات شبه أمنية مثل رصد الخروقات وضمان احترام الاتفاقات وإصدار تقارير متابعة محلّية، وهو ما عزّز ثقة الأطراف بها، ومنحها حضوراً فعلياً في ساحات النزاع. وشكّلت الإدارة الأهلية تاريخياً إطاراً مؤسّساتياً لهذه الجهود، إذ منحت القبائل رُقعاً جغرافية محدّدة تُعرف بالحواكير أو الدار،26 وأُسندت إلى زعمائها سلطات قضائية وإدارية ومالية- تلاشى هذا الدور بعض الشيء- تشمل الإشراف على المحاكم الأهلية وحلّ النزاعات المحلّية وتنظيم العلاقة بين مناطق التّماس القَبَلي.27
وشهد تاريخ الإدارة الأهلية تقلّبات وتجاذبات منذ استقلال البلد، فكان يتمّ حلّها واستبدالها بمجالس إدارية أحياناً، أو يجري استثمارها لتؤدي دوراً فعلياً في الحفاظ على الأمن والاستقرار أحياناً أُخرى. غير أنّ هذا الدور لم يكن بمنأى عن التسييس، إذ لجأت الإدارة الاستعمارية البريطانية مثلاً إلى استخدام الإدارة الأهلية كأداة لإضعاف النزعة القومية عبر زيادة الأهمّية السياسية للقبيلة، بما يعزّز الانقسام ويجعل الوحدة الوطنية أكثر صعوبة. ومنذ ذلك الحين، واصلت الأنظمة المتعاقبة الاستثمار في هذه البُنية والاستفادة منها، أحياناً من خلال تمكين بعض القيادات بالمال والمناصب في مقابل الولاء، وأحياناً أُخرى عبر إقصاء زعماء رفضوا الانصياع. وبذلك باتت الإدارة الأهلية محوراً للجدل، ولا سيّما بين المثقّفين، فهناك مَن يرى أنّ تعزيزها ضروري للحدّ من النزاعات بفضل سجلّها في تسوية الخلافات بطرق محلّية مقبولة، بينما يرى آخرون أنّ الاعتماد عليها يعمّق الانقسام القَبَلي ويكرّس المنافسة على حساب بناء دولة قومية حديثة تقوم على أسس المواطنة.28
وعلى الرغم من هذا الجدل، فإنّ الواقع الميداني يبرهن أنّ الوساطة المحلّية تعتمد على طيف أوسع من الفاعلين يتجاوز الإدارة الأهلية وحدها. فالحكماء والأجاويد يظلّون شخصيات مرموقة تتدخّل لحقن الدماء بفضل سمعتهم وحيادهم النسبي، بينما يساهم رجال الدين عبر خطابات التهدئة والدعوة إلى السلم، بل حتى الطبقات الأُخرى، كالنساء والشباب، في جهود الإغاثة وحماية الأسواق والممرّات الإنسانية، وفي الضغط المجتمعي لوقف القتال. كما أدّى المهنيون، مثل الأطباء والمعلمين، أدواراً بارزة في الوساطة لضمان استمرار الخدمات الأساسية وفتح مسارات لإجلاء الجرحى. وتُظهر هذه المنظومة الواسعة أنّ الوساطات المحلّية ليست ثابتة أو حكراً على مؤسّسة تقليدية، بل هي شبكة دينامية تتكيّف مع تغيّر طبيعة النزاع وتعقيداته.
التحدّيات والدروس المستفادة
تكشف النجاحات التي حقّقتها الوساطة المحلّية في الدول الثلاث عن سمات أساسية ودروس مهمة يمكن البناء عليها: أولاً، الشرعية الثقافية والاجتماعية هي مفتاح مهمّ للنجاح، فعدا عن أنها تضيف مُلكية وطنية لبناء السلام، فإنها تمنح الوسطاء أيضاً قوّة لا يمكن للمؤسّسات الدولية أن توفّرها؛ ثانياً، أثبتت التجربة أنّ المرونة التكتيكية التي تميّز الوساطة المحلّية تسمح لها باحتواء التصعيد بسرعة، حتى إن كانت الحلول موقّتة وجزئية؛ ثالثاً، يتّضح أنّ الوساطة المحلّية لا تستطيع أن تحلّ محلّ الدولة ومؤسّساتها في معالجة جذور النزاعات أو ضمان استدامة السلام، إلا أنها تشكّل عنصراً ضرورياً يُكْمل المسارات الوطنية والدولية؛ أخيراً، برزت مساهمة النساء والمجتمع المدني، حتى إن كانت محدودة، كعنصر يزيد من فاعلية الوساطة ويمنحها شرعية أوسع، بتجسير الهوّة بين الهياكل التقليدية والفاعلين الجدد. باختصار، إن الوساطة المحلّية، وعلى الرغم من هشاشتها، أثبتت أنها قادرة على إحداث فرق ملموس في حياة الناس، وأنها تمثّل حلقة لا يمكن الاستغناء عنها في أيّ عملية سلام شاملة.
غير أنّ هذه الآليّات المحلّية، وعلى الرغم من نجاحاتها النسبية، تصطدم بتحدّيات وعقبات نابعة من بيئة النزاع الأوسع، وتفتقر إلى أدوات تضمن استدامة الإنجاز وربطه بالمسارات الوطنية الأشمل. ويمثّل ضعف الموارد المالية واللوجستية التّحدي الأول، ذلك بأنّ الوسطاء المحلّيين، أكانوا شيوخ قبائل، أم أعياناً، أم ناشطين في مجتمع مدني، يعملون في بيئات فقيرة تفتقر إلى الدعم المؤسّساتي، وكثيراً ما تُبذل جهود الوساطة بإمكانات شخصية محدودة، الأمر الذي يجعلها رهينة الظروف المحلية، وغير قادرة على التوسّع أو الاستمرار فترات طويلة. وهذا الضعف يجعل الوسطاء عرضة للإنهاك وفقدان القدرة على المتابعة، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر باتفاقات تحتاج إلى مراقبة وتنفيذ على المدى البعيد.
يتمثّل التحدّي الثاني في التهديدات الأمنية المباشرة التي يتعرّض لها الوسطاء. ففي اليمن مثلاً، قُتل أو هُدّد العديد من الشيوخ الذين حاولوا التوسّط بين الأطراف، بينما تعرّضت الإدارات الأهلية في السودان لضغوط من الجيش أو قوات الدعم السريع للتخلّي عن حيادها. أمّا في ليبيا، فالميليشيات المسلّحة كثيراً ما ترى في الوسطاء المحلّيين عقبة أمام تعظيم مصالحها العسكرية والاقتصادية، وهو ما يجعلهم هدفاً للترهيب. وبالتالي، فإنّ هذه البيئة الخطرة تقوّض ثقة المجتمع بالعملية نفسها، إذ يخشى الناس الانخراط في مسار قد يجرّ عليهم عواقب شخصية.
أمّا التدخّل السياسي فيمثّل تحدّياً ثالثاً لا يقلّ خطورة. ففي اليمن، تسعى الأطراف المتحاربة لاستقطاب بعض المشايخ وتحويلهم إلى أدوات سياسية، الأمر الذي يقوّض صدقية الوساطة. وفي ليبيا، تستغل الميليشيات المسلّحة وحلفاؤها السياسيون المجالسَ البلدية، وحتى بعض الأعيان ومشايخ القبائل، لشرعنة وجودهم وترسيخ نفوذهم، بينما يستخدم طرفا الصراع في السودان الإدارات الأهلية أحياناً لتبرير مواقفهما. وهذه التدخّلات السياسية تُضعف استقلالية الوسطاء، وتحدّ من قدرتهم على الاضطلاع بدور محايد، وهو ما ينعكس سلباً على ثقة المجتمع المحلّي بهم.
ويُعتبر غياب الضمانات تحدّياً رابعاً يجعل كثيراً من الاتفاقات المبرمة عرضة للانهيار. فالاتفاقات التي تُبرَم عبر الوساطة المحلّية غالباً ما تكون شفهية أو غير موثّقة رسمياً، وتعتمد على الثقة والالتزام الأخلاقي أكثر من اعتمادها على آليّات مؤسّساتية تنفيذية أو قضائية. وهذا النقص في الضمانات يَظهر بوضوح في اليمن حيث انهارت اتفاقات فتح الطرق، أو تبادل الأسرى، بمجرّد تغيّر موازين القوى؛ وفي ليبيا أيضاً، انهار العديد من الهُدَن التي كان فيها توازن القوى بين الطرفين المتصارعين كبيراً؛ أمّا في السودان فكثيراً ما يتم خرق اتفاقات وقف إطلاق النار المحلّية بسبب استمرار الحرب.
الخاتمة
تكشف التجارب في اليمن وليبيا والسودان أنّ الوساطة المحلّية ليست مجرّد آليّة تقليدية لحلّ النزاعات الصغيرة، بل أداة حيوية حافظت على حياة المجتمعات في لحظات انهيار الدولة التام. فقد نجحت هذه الوساطات في تحقيق اختراقات ملموسة على مستوى حماية المدنيين، وفتح الطرق، وتبادل الأسرى، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، لكن محدوديتها تكمن في عدم قدرتها على معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، أو فرض استدامة الاتفاقات بعيداً عن إرادة القوى السياسية والعسكرية الكبرى.
وتُبرز هذه النتائج الحاجة إلى مقاربة جديدة تَعتبر الوساطة المحلّية جزءاً أساسياً من هندسة السلام، لا مجرد حل مؤقت للأزمات، إذ لا يمكن لأيّ اتفاق وطني أو أُممي أن ينجح إذا لم يتّكئ على شرعية المجتمع المحلّي وآليّاته الخاصة في فضّ النزاعات. كما أنّ تجاهل هذه الوساطات يعني ترك مساحات واسعة من النزاع بلا إدارة، وهو ما يؤدّي بالضرورة إلى عودة العنف. وممّا سبق نوصي بأنّه ينبغي للمنظّمات الدولية والإقليمية تقديم دعم مالي وتقني مستدام إلى الوسطاء المحلّيين، بما في ذلك التدريب على مهارات التفاوض وآليّات الحماية، من دون محاولة فرض وصاية خارجية عليهم. كما يجب الاعتراف رسمياً بالاتفاقات المحلّية وإدماجها في العملية السياسية الوطنية، بحيث تتحوّل من إنجازات جزئية إلى لَبِنات في مسار شامل للسلام. ومن الضروري توفير حماية فعلية للوسطاء المحلّيين من خلال آليّات مراقبة دولية وإقليمية تمنع استهدافهم أو ابتزازهم من القوى المسلّحة. ويتعيّن تعزيز الشراكات بين المجتمع المدني والهياكل التقليدية، بما يخلق جسوراً بين الشرعية الحديثة والشرعية التاريخية.
الهوامش
1 الجُودية: آليّة وساطة تقوم على تدخّل الأجاويد (الحكماء والأعيان) لحلّ النزاعات والخلافات عبر الحوار والتراضي والتعويض، بعيداً عن العقوبات القضائية الرسمية. وهم شخصيات مرموقة وموثوق بها في المجتمع، ويُستعان بهم كوسطاء لإصلاح ذات البَيْن، بسبب مكانتهم الرمزية داخل المجتمع.
2 United Nations High Commissioner for Refugees “Libya in Turmoil: Crisis in Libya: Dying for a Chance to Live,” accessed December 15, 2025, https://www.unhcr.ca/our-work/emergencies/libya/; International Organization for Migration, Libya Crisis Response Plan 2025-2026, accessed October 23, 2025, https://tinyurl.com/bdb68fjw.
3 United Nations Economic and Social Commission for Western Asia, “Cost of Conflict in Libya Exceeds $576 Billion, ESCWA Study Finds,” accessed October 23, 2025, https://tinyurl.com/6saycrnm.
4 International Organization for Migration, Yemen Crisis Response Plan 2025, accessed October 23, 2025, https://tinyurl.com/3mpfmwax; World Bank, “Economic Fragmentation and External Shocks Hamper Yemen’s Recovery Path,” June 2, 2025, accessed October 23, 2025, https://tinyurl.com/2rej2p89.
5 United Nations High Commissioner for Refugees, “Sudan Situation, Data Portal,” accessed October 23, 2025, https://tinyurl.com/4xhks8p6.
6 World Bank, Sudan Economic Update May 2025: The Economic and Social Consequences of the Conflict: Charting a Path to Recovery, accessed October 23 2025, https://documents1.worldbank.org/curated/en/099051925180542315/pdf/P178527-6a7d4d70-52be-49b7-87e5-ead89050a99b.pdf.
7 “Sudan War Shatters Infrastructure, Costly Rebuild Needed,” Reuters, May 28, 2025, accessed October 23, 2025, https://www.reuters.com/world/africa/sudan-war-shatters-infrastructure-costly-rebuild-needed-2025-05-28/.
8 “Conflict Resolution in Yemen Today: A Report for the German Development Cooperation”, GTZ Discussion Paper, 2006.
9 Rim Mugahed, “Tribes and the State in Yemen”, Sana’a Center for Strategic Studies, June 14, 2022, https://sanaacenter.org/publications/main-publications/16156.
10 One of the authors has previously attended such an arbitration gathering.
11 “Conflict Resolution in Yemen Today: A Report for the German Development Cooperation”, GTZ Discussion Paper, 2006.
12 Rim Mugahed, “Tribes and the State in Yemen”, Sana’a Center for Strategic Studies, June 14, 2022, https://sanaacenter.org/publications/main-publications/16156.
13 أحد مؤلفي موجز القضية حضر مجلس تحكيم قَبَلي في اليمن سابقاً.
14 فؤاد المجيّدي ومحمد حفيظ، “الوساطة المجتمعية في اليمن… فنّ التفاوض الذي عجزت عنه المنظمات الدولية واستغلّته”، “رصيف22″، 12 مارس 2022، في الرابط الإلكتروني التالي: https://raseef22.net/article/1086838
15 “باب نيوز”، “رابطة أمهات المختطفين تدعو للضغط على الأطراف اليمنية للإفراج عن المحتجزين منذ عقد”، “باب نيوز”، 14 سبتمبر 2025، في الرابط الإلكتروني التالي: https://www.babnews.net/news/6617
16 Norwegian Refugee Council, “Repairing Fractured Landscapes: Challenges and Opportunities for Resolving Disputes over Land, 64 Housing, Water and Other Natural Resources in Yemen” (Oslo: NRC, 2019), 39, https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/repairing-fractures-landscapes/repairing-fractured-landscapes—challenges-and-opportunities-for-resolving-disputes-over-land-housing-water-and-other-natural- .resources-in-yemen.pdf.
17 Alice Alunni, Mark Calder, and Stefanie Kappler, Enduring Social Institutions and Civil Society Peacebuilding in Libya and Syria, (London: British Council, 2017), https://www.britishcouncil.org/research-insight/peacebuilding-libya-syria.
18 Amal Obeidi, “Local Reconciliations in Libya: A Precarious Balance Sheet”, The Legal Agenda, April 30, 2019, https://english.legal-agenda.com/local-reconciliations-in-libya-a-precarious-balance-sheet/.
19 José S.Vericat, and Mosadek Hobrara, From the Ground UP: UN Support to Local Mediation in Libya, (New York: International Peace Institute, 2018), 1, https://www.ipinst.org/2018/06/un-support-to-local-mediation-libya
20 Christopher Thornton, “The Libyan Carousel: The Interaction of Local and National Conflict Dynamics in Libya”, in Conflict, Stability and Local Peace Processes, ed. Christine Bell, Jan Pospisil, and Laura Wise (Stadtschlaining, Austria: Austrian Study Centre for Peace and Conflict Resolution [ASPR] and Political Settlements Research Programme [PSRP], September 2021), 22-29.
21 Wolfram Lacher, Libya’s Fragmentation: Structure and Process in Violent Conflict (London: I.B. Tauris, 2020), pp. 133–136, 172–175.
22 “إطلاق سراح أسرى في صفقة نادرة بين الدعم السريع والقوة المشتركة بدارفور”، “سودان تربيون”، 28 سبتمبر 2024، https://sudantribune.net/article/291454
23 “تجربة لجنة الوساطة والحكْماء شمال دارفور/الفاشر: اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﻔﺮص”، “المرصد السوداني للشفافية والسياسات”، مارس 2024، https://sudantransparency.org/wp-content/uploads/2024/03/ElFasherAR.pdf
24 الناظرأو ما يقابله: أعلى سلطة في نظام الإدارة الأهلية، على رأس القبيلة، كان يمارس صلاحيات قضائية وإدارية واسعة. يليه العمدة وهو مستوى أدنى من الناظر، يرأس وحدات قَبَلية أو مناطق أصغر، ويقوم بإدارة شؤون المجتمع المحلّي والتنسيق بين الشيوخ والنظّار. بعد ذلك يأتي الشيوخ وهم قادة القرى أو الوحدات المحلّية الأصغر، يتولون حلحلة النزاعات البسيطة على مستوى المجتمعات القاعدية. ;”دارفور: مبادرة للسلم الاجتماعي بعد قطيعة 20 عاماً بين مكونَين أهليّين”، “عاين”، 8 فبراير 2023، https://3ayin.com/social-peace/
25 النور أحمد النور، “ما وراء عزل زعماء قبائل وإدارات أهلية في غرب السودان؟”، “الجزيرة”، 31 مايو 2025، https://www.aljazeera.net/politics/2025/5/31/ما-وراء-عزل-زعماء-قبائل-وإدارات-أهلية
26 الحاكورة قطعة أرض كبيرة أو منطقة خاصة بإحدى القبائل كموطن تاريخي لها، يُدار من خلالها نظام الإدارة الأهلية، وهي من أبرز مصادر النزاعات، وخصوصاً في دارفور. أمّا الدار، وهي تسمية مشابهة للحاكورة في مناطق أُخرى من السودان، وخصوصاً في كردفان، فتشير إلى نطاق جغرافي تُنسب مُلكيته إلى قبيلة أو مجموعة معينة.
27 عثمان الأسباط، “الإدارة الأهلية في السودان… هل من دور منتظر؟”، “إندبندنت” عربية”، 1 مايو 2023، https://www.independentarabia.com/node/446416/سياسة/تقارير/الإدارة-الأهلية-في-السودان-هل-من-دور-منتظر؟
28 عبده مختار موسى، “أثر القَبَلية في الاستقرار السياسي في السودان (حالــة دارفـور)”، “مركز دراسات الوحدة العربية”، 9 مايو 2019، https://caus.org.lb/أثر-القبلية-في-الاستقرار-السياسي-في-ال/؛ “كيف يحاول العسكر احتواء الإدارات الأهلية وتوظيفها لخدمة أجندتهم السياسية؟” “بيم ريبورت”، 22 مايو 2022، https://www.beamreports.com/2022/05/22/كيف-يحاول-العسكر-احتواء-الإدارات-الأه/