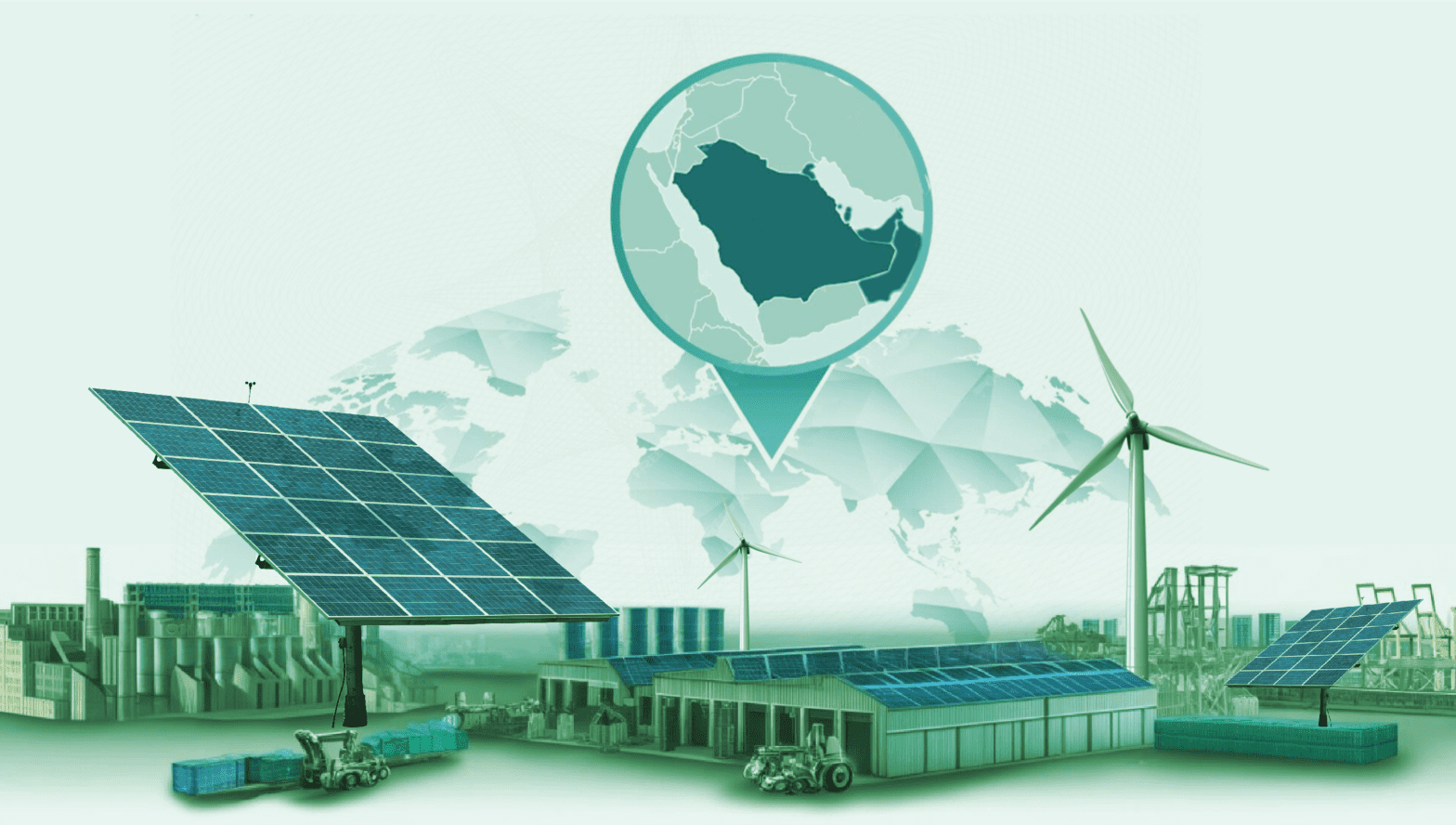
توطين سلاسل إمداد الطاقة المتجدّدة في الخليج:
الطموحات والتحدّيات والمسارات الإستراتيجيّة
موجز قضية، مايو 2025
النقاط الرئيسيّة
الدول الخليجية تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين الأهداف الطموحة والتحدّيات الهيكليّة: على الرغم من أنّ الدول الخليجية غنيّة بموارد النفط والغاز، بدأت تتّجه تدريجياً نحو التحوّل في مجال الطاقة. غير أنّ جهودها لتوطين سلاسل إمداد الطاقة المتجدّدة تصطدم بحواجز كبيرة، في مقدّمتها الفجوات التكنولوجية ونقص الكفاءات المتخصّصة ومحدودية الأسواق المحلّية والمنافسة الحادّة مع الصين.
إستراتيجيّات وطنية متباينة وأهداف مشتركة: تتبنّى الدول الخليجيّة مقاربات مختلفة لتوطين سلاسل إمداد الطاقة المتجدّدة وتعزيز أمنها في مجال الطاقة، عبر فرض نسب للمحتوى المحلّي وتطوير مناطق حرّة وتقديم حوافز للمستثمرين وإنشاء منشآت محلّية، مع الحفاظ على قدر من المرونة القائمة على السوق.
تأمين المعادن الحرجة والقدرات التصنيعية ركيزة أساسية في المرحلة المتوسّطة: يُعدّ تأمين المعادن الحرجة وتوسيع نطاق التصنيع في المراحل المتوسّطة عنصراً حاسماً لبناء قطاع محلّي مرن للطاقة المتجدّدة. ومع استمرار هيمنة الصين على عمليات تكرير المعادن الأرضية النادرة والمدخلات الرئيسية، ينبغي على الدول الخليجية تعزيز البحث والتطوير في مجال الطاقة المتجدّدة واستقطاب الاستثمارات لدعم الإنتاج المحلّي.
ضرورة التنسيق الإقليمي كمدخل لدمج الأسواق وتحقيق وفورات الحجم: يمكن لإستراتيجية موحّدة على مستوى مجلس التعاون الخليجي أن تساهم في حشد الطلب وترشيد الاستثمارات وتعزيز التعاون العابر للحدود. ويُعدّ نقل التكنولوجيا واستدامة البحث والتطوير والتوظيف الإستراتيجي لصناديق الثروة السيادية، من العناصر الجوهريّة لبناء سلسلة إمداد تنافسية ومتكاملة للطاقة المتجدّدة في الخليج.
المقدّمة
على الرغم من الثروة الوفيرة التي تمتلكها دول مجلس التعاون الخليجي من النفط والغاز، فإنّها تتقدّم بحذر في مسار التحوّل في مجال الطاقة. وقد دفعتها الضغوط الدولية المتزايدة لخفض انبعاثات الكربون، إلى جانب تراجع تكاليف تكنولوجيا الطاقة الشمسية والرياح والحاجة الاقتصادية الملحّة إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، إلى استكشاف سلاسل إمداد الطاقة المتجدّدة كوسيلة لتنويع اقتصاداتها وتعزيز أمنها الطاقي.1
بعدما كانت دول مجلس التعاون الخليجي، أي البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تعتمد بشكلٍ رئيسي على استيراد منتجات الطاقة المتجدّدة وتقنياتها، بدأت اليوم تتوجّه نحو إنشاء صناعات وسلاسل إمداد محلَية لتقنيّات الطاقة الشمسية والرياح. ونظراً لهيمنة الصين على أكثر من 80 في المئة من السوق العالمية للطاقة الشمسية وأكثر من 60 في المئة من إنتاج مكوّنات طاقة الرياح،2 يمكن القول إنّ الدول الخليجيّة لا تزال تعتمد على الواردات إلى حدّ كبير. فعلى سبيل المثال، استوردت الإمارات العربية المتحدة نحو 99 في المئة من وحدات الطاقة الشمسية من الصين في السنوات القليلة الماضية، بينما اعتمدت سلطنة عُمان على الواردات الصينية لتغطية ما يقارب 80 في المئة من حاجها من الألواح الشمسيّة الكهروضوئية.3
ومع ذلك، تعمل كل دولة خليجية على الحدّ من هذا الاعتماد من خلال سياسات موجّهة، مثل متطلّبات المحتوى المحلّي في المملكة العربية السعودية، وحوافز المناطق الحرّة في عُمان، وإستراتيجية السوق المفتوحة في الإمارات، وجهود قطر لتشييد منشأة لإنتاج مادة البولي سيليكون، وهي مادة خام أساسيّة تُستخدم في تصنيع خلايا الطاقة الشمسية.4 بالتالي، فإنّ المنطقة بصدد تطوير سلسلة قيمة محلّية، وقد أحرزت تقدّماً ملموساً في مجال السياسات والاستثمارات. غير أنّها تواجه تحدّيات هيكليّة تعيق توسيع قدراتها التصنيعية بما يتيح لها منافسة المورّدين العالميين التقليديين.
يتناول موجز القضيّة هذا تطوّر جهود التوطين في شتى أنحاء الخليج، ويقيّم قدرتها على تحويل المنطقة من مستوردٍ صاف إلى لاعبٍ تنافسي ومستقلّ في سوق الطاقة المتجدّدة العالمية. كما يستعرض التحدّيات القائمة، بدءاً من الفجوات التكنولوجية ونقص الكفاءات، وصولاً إلى محدودية قدرات الأسواق المحلّية، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي.
الطموحات المتجدّدة ومفارقة التحوّل
لطالما تعاملت دول مجلس التعاون الخليجي مع جهود مكافحة تغيّر المناخ بنوع من التشكيك، إذ اعتبرتها تحدّياً مباشراً لنماذجها الاقتصادية.5 ويُعزى هذا التحفّظ في اعتمادها الكبير على صادرات الوقود الأحفوري، التي تشكّل نسبة كبيرة من الناتج المحلّي الإجمالي وعائدات الحكومة ومعدّلات التوظيف الوطني. فقطاع الهيدروكربونات لا يغذّي اقتصاداتها المحلّية فحسب، بل يهيمن أيضاً على أسواق الطاقة العالمية، ما يجعل أيّ تحوّل مفاجئ إلى مصادر الطاقة المتجدّدة احتمالاً مستبعداً للغاية. علاوة على ذلك، لقد صاغت الدول الخليجية إستراتيجيّاتها المناخية إلى حدّ كبير حول محاور متعدّدة منها: خفض انبعاثات الكربون، وإنتاج الهيدروجين، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بدلاً من تطوير صناعات محلّية للطاقة المتجدّدة.
فيما تتوقّع الوكالة الدوليّة للطاقة أن يبلغ الطلب على النفط ذروته في خلال هذا العقد،6 ترى منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، التي تقودها الدول الخليجية بشكلٍ أساسي، أنّ هذه الذروة ليست وشيكة وأنّ الطلب سيواصل الارتفاع حتى العام 2050 على الأقل.7 يتماشى ذلك مع إستراتيجيّة الأوبك على نطاقٍ أوسع للمحافظة على حصّة سوق النفط وفي الوقت نفسه توسيع نطاق الاستثمارات في الطاقة المنخفضة الكربون. وفي العام الماضي، أعاد وزير الطاقة السعودي التأكيد على التزام المملكة بتعزيز تقنيّات الطاقة النظيفة في ظلّ ضمان هيمنتها على أسواق النفط والبتروكيماويات.8وتتبنّى دولٌ خليجية أخرى هذا النهج، إذ ترى في عائدات الوقود الأحفوري عنصراً لا غنى عنه لتحسين مستوى المعيشة وتمويل جهود التحوّل في مجال الطاقة وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي الطموحة.
إلّا أنّ الضغوط المناخية المتصاعدة والحاجة المتزايدة إلى التنويع الاقتصادي تدفع دول المنطقة على إعادة تقييم إستراتيجياتها، سعياً لتحقيق التوازن بين اعتمادها المستمرّ على الوقود الأحفوري في توليد الطاقة المحلّية وأهدافها الطموحة في مجال الطاقة المتجدّدة. وقد ساهمت التهديدات المتمثّلة بارتفاع مستويات سطح البحر والحرارة القصوى وندرة المياه المزمنة في تنامي الوعي بشأن المخاطر المناخية،9 ما انعكس على تغيّر الخطاب والسياسات في مختلف دول المجلس، تحت تأثير عوامل اقتصادية وجيوسياسية، ولا سيّما الحاجة إلى الاستفادة القصوى من صادرات الوقود الأحفوري تماشياً مع التحوّلات العالمية في مجال الطاقة. ويجسّد هذا التحوّل توجّهاً أكثر استباقيةً في التكيّف مع تغيّر المناخ والحدّ من آثاره، في ظلّ تنفيذ مشاريع متعدّدة والتخطيط لعددٍ أكبر من المشاريع الأخرى.10 وتُشير تقديرات مختلفة إلى أنّ دول مجلس التعاون الخليجي يمكنها إضافة أكثر من 85 غيغاواط من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجدّدة بحلول منتصف العقد 11.2030
وفي حين أنّ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في طليعة التحوّل إلى الطاقة المتجدّدة في الخليج، حدّدت الدول الأعضاء كافة في مجلس التعاون الخليجي أهدافاً في مجال الطاقة المتجدّدة وتعهدات لخفض الانبعاثات وأهدافاً للحياد الكربوني (أنظر الجدول 1). وتحرص المملكة العربية السعودية على توليد نصف احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجدّدة بحلول العام 2030، وعلى توطين أجزاء من سلسلة الإمداد بغية تعزيز الصناعة المحلّية.12 من جهتها، تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق نسبة 44 في المئة كحصّة الطاقة النظيفة من مزيجها الإجمالي بحلول العام 2050، بما في ذلك 6 في المئة كطاقة نووية، بهدف تلبية الطلب المتصاعد على الطاقة وخفض الانبعاثات.13 ووضعت دول خليجية أخرى أهدافاً طموحة نصب عينيها: تحرص عُمان مثلاً على تأمين 10 في المئة من طاقتها من المصادر المتجدّدة بحلول العام 2025 و20 في المئة بحلول العام 14.2030 وقد التزمت قطر بتحقيق نسبة 30 في المئة من المصادر المتجدّدة في مزيجها للطاقة بحلول العام 15،2030 فيما رفعت البحرين هدفها مؤخراً إلى نسبة 20 في المئة بحلول العام 2030؛16 أمّا الكويت فتسعى إلى تحقيق نسبة 15 في المئة بحلول العام 17.2030
الجدول 1: الأهداف المتعلّقة بالطاقة المتجدّدة في دول مجلس التعاون الخليجي
| الدولة | هدف خفض الانبعاثات | هدف الطاقة المتجدّدة | الطاقة المتجدّدة الإجمالية (2023) |
| قطر | 25 في المئة بحلول 2030 مقارنة بسيناريو العمل كالمعتاد للعام 2019 | بين 2 و4 غيغاواط بحلول 2030 | 824 ميغاواط؛ 7,2 في المئة |
| البحرين | 30 في المئة بحلول 2035 مقارنة بسيناريو العمل كالمعتاد للعام 2015 | 20 في المئة من مزيج الطاقة بحلول 2030 | 59 ميغاواط؛ 0,6 في المئة
|
| عُمان | 7 في المئة بحلول 2030 مقارنة بسيناريو العمل كالمعتاد للعام 2019 | 20 في المئة من الكهرباء بحلول 2030 | 722 ميغاواط؛ 6,2 في المئة |
| الكويت | 7,4 في المئة بحلول 2035 مقارنة بسيناريو العمل كالمعتاد للعام 2015 | 15 في المئة من الطاقة بحلول 2030 | 114 ميغاواط؛ 0,6 في المئة |
| الإمارات العربية المتحدة | 19 في المئة بحلول 2030 مقارنة بالعام 2019 | مضاعفة حصّة مصادر الطاقة المتجدّدة ثلاث مرات بحلول العام 2030؛ 44 في المئة من القدرة الإنتاجية بحلول 2050 | 6000 ميغاواط؛ 13,8 في المئة |
| المملكة العربية السعودية | 278 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً مقارنة بالعام 2019 | 50 في المئة من الكهرباء بحلول 2030 | 2988 ميغاواط؛ 3,3 في المئة |
المصدر: البيانات المتعلّقة بأهداف الطاقة المتجدّدة وخفض الانبعاثات مستمدّة من تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة (IRENA): أسواق الطاقة المتجدّدة: مجلس التعاون الخليجي 2023. أمّا البيانات حول القدرة المركّبة، فقد جُمعت من تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة: إحصاءات الطاقة المتجدّدة للعام 2023.
على الرغم من هذه الأهداف الطموحة، لا تزال الفجوة كبيرة بين ما هو مُعلن وما تحقّق فعلياً في مجال الطاقة المتجدّدة حتى اليوم. فاعتماد المصادر المتجدّدة لا يزال يسير ببطء، في حين قد تؤدّي مواصلة الاستثمارات الخليجية في مشاريع تحويل النفط إلى كيماويات، ومشاريع الغاز الطبيعي، وتقنيات تعزيز استخراج النفط، إلى إضعاف جهود تطوير سلاسل إمداد تنافسية في مجال الطاقة المتجدّدة. ويمكن أن يُكلّف ذلك الاقتصادات الخليجية خسارةً كبيرة في نقل التكنولوجيا وغيرها من المضاعفات المترتبة عليها، ويرسّخ في المقابل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويحدّ من القدرة المالية والسياساتية والصناعية الضرورية لتوسيع نطاق الصناعة المحلّية لمصادر الطاقة المتجدّدة. وفي حال عدم تطوير الإنتاج المحلّي، من استخراج المواد الخام إلى تصنيع المكوّنات المتقدّمة، تُفوّت المنطقة فرصاً لبناء صناعات عالية القيمة تُسهم في خلق الوظائف وتحقيق التنويع الاقتصادي. وفي غياب سلاسل إمداد محلّية، ستبقى التكنولوجيا والمعرفة التقنية اللازمة للتصنيع المتقدّم حكراً على الشركاء الخارجيين.18
يُواجه التحوّل إلى الطاقة المتجدّدة في الدول الخليجية تحدّيات كبيرة، لا سيّما بسبب اعتماد المنطقة المزمن على الهيدروكربونات.19 على مرّ التاريخ، أعطى نموذجُ المنطقة الاقتصادي الأولويّة لصناعات الوقود الأحفوري، ما قلّص الحوافز لتوسيع أسواق الطاقة المتجدّدة بسرعة. ويزيد دعمُ الوقود الأحفوري وتعريفات الكهرباء المنخفضة عمليّةَ التحوّل تعقيداً،20 إذ تُخفّض تكلفة الهيدروكربونات بشكلٍ اصطناعي وتجعل البدائل المتجدّدة أقلّ جاذبية في الأسواق المحليّة. وعلى الرغم من إدخال بعض الإصلاحات، تستمرّ الانحرافات في أسعار الطاقة، مُعيقةً القدرة التنافسيّة لأسواق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
تُشكّل هياكل الحوكمة عائقاً إضافياً21 أمام التحوّل في قطاع الطاقة. إذ تقود شركات الطاقة الوطنية قطاعات الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل رئيسي، ويبدو أنّ دافعها لإعطاء الأولوية لتطوير الطاقة المتجدّدة محدود.22 علاوة علي ذلك، غالباً ما تُتّخذ القرارات بصورة مركزية، ولقطاع الهيدروكربون تأثير في سياسات الطاقة، ما يؤدّي إلى التركيز على تحقيق الأهداف المالية قصيرة ومتوسطة الأجل. ويطغى هذا النهج أحياناً على أولوية أهداف الاستدامة طويلة الأجل، ما قد يُعيق الجهود المبذولة لمعالجة الاعتبارات البيئية والاجتماعية الأوسع.23 علاوة على ذلك، تُقاوم الصناعات الاستخراجية والنقل، المعتمدة على الهيدروكربونات إلى حدّ كبير، تَبنّي ممارسات مستدامة، ما ينتج حالة من الجمود المؤسّسي تُبطئ وتيرة التحوّل. ويرى الخبراء أنّ تسريع التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجدّدة يتطلّب إصلاحات في الحوكمة،24 تشمل توسيع مشاركة القطاع الخاص وتحسين الأطر التنظيميّة وتوضيح الأدوار والمسؤوليات بين مختلف مرافق الطاقة ووكالاتها الوطنية.25
التحوّل في الخليج وهيمنة الصين
تسعى دول خليجية متعدّدة إلى توطين إنتاج مكوّنات الطاقة المتجدّدة، بهدف بناء سلاسل إمداد مرنة وتقليص اعتمادها على مصدرٍ واحد. غير أنّ هذه الجهود تصطدم بعقبات كبيرة، بسبب انطلاقتها المتأخّرة وهيمنة المورّدين العالميّين الحاليين للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وعلى رأسهم الصين. في الواقع، تهيمن بكين على القطاع العالمي للمصادر المتجدّدة، بما فيه التعدين والتكرير ومعالجة المواد الخام. فهي تقوم بتكرير أكثر من 80 في المئة من عناصر الأرض النادرة في العالم التي تُعدّ أساسيّة في صناعة مغناطيسات توربينات الرياح وتخزين البطاريات. وحتى العام 2021، أنتجت الصين 79 في المئة من مادة البولي سيليكون في العالم، و97 في المئة من الرقائق، و85 في المئة من الخلايا الشمسية، بالإضافة إلى أكثر من 80 في المئة من معدّات الطاقة الشمسية و60 في المئة من مكوّنات طاقة الرياح، ويعود هذا التفوّق إلى سياسة صناعية متكاملة رأسياً وتمويل ضخم وسيطرةٍ إستراتيجيّة على المواد الخام.26
لكي تتمكّن الدول الخليجيّة من تصنيع منتجات نهائية، ينبغي عليها الاستثمار في مشاريع مستقبليّة تهدف إلى تقليص الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية الضخمة. غير أنّ ذلك يطرح معضلة: فيما توفّر الروابط الوثيقة مع الصين التكنولوجيا العالية الجودة والفعّالة من حيث التكلفة، ما يسمح بتحقيق تعريفات شمسية منخفضة قياسية، يُعيق الاستمرار في الاستيراد التقدّمَ نحو التوطين. ويبقى التحدّي الأساسي في قدرة الدول الخليجية على التحوّل من مشترٍ غير فاعل إلى لاعبٍ ناشط ومؤثّر في سلاسل إمداد الطاقة المتجدّدة.
في ظلّ تصاعد الطلب العالمي على المنتجات المتجدّدة مثل البطاريات وغيرها من السلع الاستهلاكية، وفيما تُسرّع الولايات المتحدة جهودها لتقليص نفوذ الصين في سلاسل الإمداد الخاصة بها، قد تميل هذه الديناميّة التعاونية نحو المنافسة بشكلٍ متزايد. فمن جهة، تتيح جهود الغرب لفك الارتباط عن التكنولوجيا الصينيّة فرصاً أمام الدول الخليجية لجذب استثمارات متنوّعة ونقل التكنولوجيا، بما يعزّز موقعها كمركزٍ إستراتيجي لتصنيع مكوّنات الطاقة المتجدّدة. ومن جهةٍ أخرى، قد تُؤدّي التوتّرات الجيوسياسيّة المتصاعدة إلى تعطيل تدفّق التكنولوجيا ورؤوس الأموال الصينية، ما يرفع التكاليف ويزعزع سلاسل الإمداد ويشكّل تحدياً أمام الأسواق الخليجيّة. في نهاية المطاف، سيعتمد النجاح على قدرة المنطقة على استثمار موقعها الجغرافي وتعزيز كفاءاتها البشرية والتكنولوجية، وتنفيذ سياسات منسّقة تضمن الاستفادة القصوى من هذه التحوّلات العالمية.
توطين الطاقة المتجدّدة: التباين في السياسات
تُعزى جهود الدول الخليجية لتطوير سلاسل الإمداد المحلّية للطاقة المتجدّدة إلى ضرورتَين متلازمتين، هما التنويع الاقتصادي وتعزيز أمن الطاقة. تلتزم قطر بالمحافظة على الزخم في قطاع المصادر المتجدّدة كجزءٍ من رؤيتها الوطنية 2030، بهدف إنتاج التقنيّات الشمسية محلّياً وتعزيز قيمة القطاع. وعلى الرغم من أنّ قطر كانت تستعدّ لقيادة منطقة الخليج والشرق الأوسط من خلال أول منشأة لإنتاج مادة البولي سيليكون،27 والتي يُفترض أن تديرها شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية (QSTec) بسعة سنوية تبلغ 8000 طن متري من البولي سيليكون عالي الجودة؛ إلّا أنّ المشروع لم يحقّق بعد إمكاناته التشغيلية الكاملة.28 وفي العام 2024، استثمرت قطر في شركة “تيك ميت” (TechMet) الاستثمارية للتعدين ومقرّها دبلن، بهدف تطوير أصولها الحالية وتوسيع محفظتها من المعادن الحرجة، مثل الليثيوم والنيكل والكوبالت والمعادن الأرضيّة النادرة.29
وقد انتهجت سلطنة عُمان مقاربة قائمة على الاستثمار، مستخدمةً المناطق الحرّة والحوافز الضريبية لجذب مُصنّعي الطاقة المتجدّدة. وفي العام 2017، أُنشئ مصنع لتجميع الوحدات الشمسية بكلفة 94 مليون دولار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لإنتاج الألواح الكهروضوئية بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي ألف ميغاواط، وذلك بالتعاون مع شركة “نيخجيا زونكي جيايي نيو إنيرجي” (Ningxia Zhongke Jiaye New Energy) وصندوق الاستثمار العُماني.30 وفي العام 2022، دشّنت “الشركة الدولية للصناعات المتقدمة” (Advanced Industries Inc.)، وهي شركة أمريكية، منشأة لإنتاج الألواح الشمسيّة بقدرة إنتاجية سنوية قدرها 200 ميغاواط، وبتكلفة 1,35 مليار دولار، بما فيها مصنع لإنتاج البولي سيليكون.31
و بدأت عمان مؤخّراً في تطوير أول منشأة لتصنيع توربينات الرياح في منطقة الدقم الاقتصادية بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 1000 ميجاوات، بقيادة شركة موارد توربين بالشراكة مع مجموعة شنغهاي إلكتريك لطاقة الرياح.32 علاوة على ذلك، وقّعت “شركة تنمية معادن عُمان” (MDO) مؤخّراً اتفاقيّة امتياز مع وزارة الطاقة والمعادن لاستكشاف منطقة في ولاية محوت تحتوي على كميّات كبيرة من رواسب السيليكا عالية النقاء، بالإضافة إلى الحجر الجيري والدولومايت، التي تُعدّ عناصر أساسيّة في تصنيع الرقائق والخلايا الشمسية.33 وبفضل احتياطيات السيليكا الخام التي تتخطّى مستويات نقائها 97 في المئة، تُخوّل الاتفاقيةُ شركةَ تنمية معادن عُمان بأن تصبح أوّل شركة مخصّصة لاستخراج رمال السيليكا، معزّزةً بذلك إستراتيجيّة الدولة على نطاقٍ أوسع لتنويع محفظتها المعدنيّة وتحفيز النمو الصناعي وتمتين الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وإذا ثبت أنّ احتياطيات عُمان من السيليكا كافية لتلبية احتياجات السوق الخليجية، فقد تتمكّن المنطقة من بناء شبكة تصنيع محلّية للطاقة المتجدّدة أكثر تكاملاً.
في المقابل، اعتمدت الإمارات العربية المتحدة إستراتيجيّة قائمةً على السوق تُفضّل المرونة التنظيمية والحوافز التجارية على شروط التوطين الصارمة. بشكلٍ خاص، فرضت دُبي نفسها كمركزٍ إقليمي لتجميع منتجات الطاقة المتجدّدة، مستقطبةً الشركات الصينيّة لإنشاء مصانع لتجميع الزجاج الشمسي والوحدات الشمسيّة.34 وبينما ساهم ذلك في تسريع وتيرة التنفيذ وجذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة، لم يقلّص بشكلٍ جذري الاعتماد على المكوّنات الوسيطة الصينيّة، لا سيّما في المجالات الدقيقة مثل إنتاج رقاقات السيليكون وتخزين البطاريات وتقنيّة المحوّلات الكهربائية.
تستثمر الإمارات العربية المتحدة أيضاً في قطاع التعدين في أفريقيا وأمريكا اللاتينيّة دعماً لعمليّة التحوّل وتحقيق أهداف صناعية.35 فقد وقّعت في العام 2023 على صفقة بقيمة 1,9 مليار دولار مع شركة التعدين الحكومية “ساكيما” (Sakima) في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتطوير عددٍ من المناجم والحصول على امتيازات في معادن القصدير والتنتالوم والتنغستن والذهب.36 بالإضافة إلى ذلك، استحوذت “مجموعة الموارد الدولية” (IRH) الإماراتية على حصّة 51 في المئة في شركة “موباني كوبر ماينز” (Mopani Copper Mines) في زامبيا مقابل 1,1 مليار دولار.37 وأعلنت مجموعة الموارد الدولية في العام 2024 عن توقيع اتفاقات للمشاريع المشتركة في أنغولا، وأجرت مناقشات متقدّمة في بوروندي وتنزانيا وكينيا لاستخراج مجموعة أوسع من المعادن الحرجة.38 تعكس هذه المبادرات نيّة الإمارات الإستراتيجيّة لبناء سلسلة إمداد متنوّعة من المواد الخام -وهي خطوة تستند إلى العِبَر المستقاة من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجدّ. بيد أنّ هذه الإستراتيجية تحمل مخاطر جيوسياسية في طياتها، لا سيّما في المناطق التي تشهد تصاعداً للنزعة القومية حيال الموارد. لقد أعادت حكومات بوركينا فاسو ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية التفاوض على عقود مماثلة وصادرت أصولاً ذات الصلة، مستهدفةً بشكلٍ رئيسي الشركات الغربية ومدقّقة أيضاً وبشكلٍ متزايد في الاستثمارات الصينية والخليجية.39 وما لم تتعامل الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول الخليجية مع هذه المخاطر بحذر وتخطيط استباقي، فقد يتعرّض أمن مواردها للخطر على المدى البعيد، ما يهدّد بإجهاض طموحاتها الأوسع في مجال الطاقة المتجدّدة.
أمّا في المملكة العربية السعودية، فقد تحوّل الزخم نحو التوطين إلى إستراتيجيّةٍ صناعية تسعى إلى تحويل سلسلة إمداد الطاقة برمّتها. فقد شدّد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان على التزام المملكة بتوطين 75 في المئة من قطاع الطاقة، ليس من خلال زيادة متطلّبات المحتوى المحلّي بشكلٍ تدريجي فحسب،40 بل عبر مقاربة متكاملة كلّياً ترتكز على استخراج المواد الخام والتصنيع المتقدّم وتجميع المنتجات النهائية. يُلزم البرنامج الوطني للطاقة المتجدّدة (NREP) المطوّرين بتأمين نسبة تتراوح بين 17 و18 في المئة من المكوّنات من مصادر محلّية ويفرض غرامات صارمة على الذين لا يبلغون عتبة 11,5 في المئة كحدّ أدنى.41
أطلقت المملكة مجموعة من الحوافز لتعزيز التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل للمواطنين، إلى جانب تطوير التكنولوجيا والقدرات، بما في ذلك الدعم للمصنّعين السعوديين في الحصول على التمويل للتصدير.42 بالتالي، أسّست شركات متعدّدة في المملكة العربية السعودية حضوراً لها في سلسلة الإمداد المحلّية. على سبيل المثال، أطلقت شركة “بي في هاردوير” الإسبانية (PV Hardware) وشركة “سولار إيدج” (SolarEdge) الإنتاج المحلّي لأجهزة التتبّع والمحوّلات الكهربائية، في حين بدأت شركة “تكنولوجيات الصحراء” (Desert Technologies)، التي أطلقت أول مصنع للألواح الشمسية في المملكة في العام 2011 بطاقةٍ إنتاجية سنوية تبلغ 300 ميغاواط، تصدّر إلى الأسواق العالمية وتوسّعت لتشمل تخزين الطاقة وأنظمة شحن المركبات الكهربائية.43 بالإضافة إلى ذلك، استحوذت شركة “الفنار” (Alfanar) السعودية على شركة “سنفيون إنديا” (Senvion India) في العام 2021 بهدف تعزيز توطين صناعة توربينات الرياح في المملكة العربية السعودية والاستفادة من السوق الهندية. من جهته، أبرم “صندوق الاستثمارات العامة” (PIF) في يوليو 2024 شراكة مع القادة الصينيين لبناء مشروع بقدرة 30 غيغاواط للسبائك والرقائق المندمجة في الخلايا لصنع وحدات الطاقة الشمسية ولصناعة مكوّنات توربينات الرياح وتجميعها، بما فيها الشفرات، بطاقةٍ إنتاجية سنويّة مقدّرة بنحو 4 غيغاواط.44
في العام 2023، ناقشت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة سُبل استيراد المعادن الحرجة من أفريقيا. والتزمت الرياض باستثمار 15 مليار دولار في قطاع التعدين العالمي (مع تركيز خاص على تأمين المواد الخام من الدول النامية)، وذلك بهدف تعزيز عمليات التكرير المحلّي وتحقيق هدفها بإنتاج 500 ألف مركبة كهربائية بحلول العام 45.2023 تعتبر المملكة التعدين الركيزة الثالثة من رؤيتها للعام 2030، وتسعى إلى رفع مساهمته من 17 مليار دولار سنوياً إلى 64 مليار دولار بحلول العام 2035، مستفيدةً من موارد معدنية غير مستغلّة تقُدّر قيمتها بنحو 2,5 تريليون دولار.46 غير أنّ جوهر هذه الإستراتيجية يتمثّل في تطوير المواد الخام للطاقة المتجدّدة، مثل السيليكا والليثيوم والبلاتين والنحاس والبوكسيت. على سبيل المثال، تملك المملكة نحو 6 في المئة من احتياطيات السيليكا العالمية، بنقاء عالٍ يبلغ 99,7 في المئة، وهي مادّة أساسية في تصنيع الألواح الشمسية.47
وكذلك، تُسلّط جهود السعودية، بما فيها مبادرة شركة منارة المعادن (Manara Minerals) ومشاريع شركة “أرامكو” (Aramco) السعودية وشركة معادن لاستخراج الليثيوم، الضوء على سعي الرياض إلى إنشاء سلاسل إمداد محلّية متكاملة للموارد الحرجة.48 اعتباراً من العام 2024، تشغّل شركة “معادن” 17 منجماً وموقعاً محلّياً.49 وقد أعلنت شركة “ليثيوم إنفينيتي” (Lithium Infinity) مؤخّراً أنّها نجحت في استخراج الليثيوم من مياه مصاحبة للنفط ضمن عيّنات من حقول “أرامكو”، وأنّها تعتزم إطلاق برنامج تجاري تجريبي لاستخراجه مباشرةً في وقت قريب.50 وفي حال نجاح هذا المشروع، يمكن أن تكرّره الدول الخليجية الأخرى الغنية بالنفط. بالفعل، سبق أن أنشأت “أرامكو السعودية”51 وشركة معادن مشروعاً مشتركاً لاستخراج الليثيوم،52 ما يبرز جهود المملكة في تطوير قطاع التعدين وتأمين سلاسل إمدادات محلّية للمعادن الحرجة. وفي العام 2024، وقّعت المملكة العربية السعودية على اتفاقات بقيمةٍ تفوق 9 مليارات دولار مع شركة التعدين الهندية “فيدانتا” (Vedanta) و”مجموعة زيجين الصينية للتعدين” (Zijin Mining Group) وشركة ” بلاتينوم غروب ميتالز” الكندية (Platinum Group Metals)، لتطوير مصاهر ومصافي النحاس والزنك والبلاتين والبلاديوم.53
وفي العام 2023، كشفت شركة “فالي للمعادن الأساسية” (Vale Base Metals) عن خطط لبناء مراكز صناعية كبرى في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لمعالجة خام الحديد بهدف تلبية احتياجات أسواق الصلب المحلّية والعالمية.54 وتتمتّع السعودية أيضاً بوصول إلى قاعدة واسعة من الموارد المحلّية، تضمّ معادن مثل النحاس والذهب والزنك.55 وعلى نحو مشابه، يمكن للقدرات الحالية في مجال تصنيع الكابلات وإدارة المشاريع والخدمات القانونية وقطاع البناء، أن تساهم في دعم مشاريع الطاقة المتجدّدة على نطاق واسع. وفي حين أنّ هذه الصناعات تعمل حالياً بطريقة مجزأة، فإنّها تمثّل نقاط انطلاق حاسمة لتطوير نظام بيئي شامل متكامل للطاقة المتجدّدة، بحيث تؤدّي السياسات المنسّقة والاستثمارات الإستراتيجية إلى سدّ الفجوات بين هذه القطاعات وسلسلة القيمة الأساسية للطاقة المتجدّدة.
بالفعل، تتمتّع دول مجلس التعاون الخليجي بموارد قيّمة تمكّنها من دعم سلاسل الإمداد في مجال الطاقة المتجدّدة. وفي حال تمكّنت من الوصول إلى التكنولوجيا الضرورية، فيُمكنها بمعظمها استثمار مواردها الوفيرة من الإشعاع الشمسي، بالإضافة إلى المواد الخام مثل السيليكا لإنتاج الألواح الشمسية محلّياً. وقد أفادت شركة الاستشارات الأمريكية “سيندكايتد أناليتيكس” (Syndicated Analytics) بأنّ سوق رمل السيليكا في دول مجلس التعاون الخليجي يُتوقَّع أن يسجّل معدّل نمو سنوي مركّب بنسبة 6,7 في المئة بين عامَي 2022 و2027 ، ليصل إلى نحو 513,5 مليون دولار بحلول العام 2027.56 علاوة على ذلك، تستطيع الصناعات المحلّية، مثل إنتاج الألومنيوم والصلب والإسمنت، أن توفّر مدخلات أساسية للبنية التحتية التقليدية بحيث تستخدّم هذه المواد في أبراج توربينات الرياح والهياكل المثبّتة للألواح الشمسية وإطارات الوحدات. غير أنّ هذه الصناعات لطالما ارتكزت على البناء التقليدي وغالباً ما تفتقر إلى الخبرات المتخصّصة ومراقبة الجودة اللازمة لإنتاج مكوّنات عالية الأداء تُلبّي متطلبات مشاريع الطاقة المتجدّدة. لذلك، فإنّ إنشاء سلسلة إمداد متينة في هذا المجال لا يتطلّب طاقة الإنتاج الخام فحسب، بل أيضاً خبرات تقنية موجّهة وقدرات تصنيع متكاملة تمتثل للمعايير الصارمة التي تفرضها صناعة الطاقة المتجددة.
إذا ما كُتب لهذه الخطط النجاح في نهاية المطاف، فقد تنشأ سلاسل إمداد أقوى وأقل اعتماداً على الواردات. ومع ذلك، فإنّ بناء القدرات سيستغرق وقتاً. وتعكس هذه الإستراتيجيات المتباينة المقاربة المتعدّدة الأوجه التي تعتمدها الدول الخليجية في بناء سلاسل إمداد خاصة بالطاقة المتجدّدة. من جهتها، تركّز المملكة العربية السعودية على الاستفادة من مواردها المحلّية وإدماج قطاع التعدين في عملية تحوّل صناعي شامل. أمّا الإمارات العربية المتحدة، فتحرص على الاستثمار في الخارج على نطاقٍ واسع من أجل تنويع محفظتها المعدنية والحدّ من مخاطر الإمدادات، في حين أنّ قطر تضخّ استثمارات في مشاريع التعدين العالمية، إلى جانب تطوير منشآت محلّية كبيرة لإنتاج تكنولوجيا الطاقة المتجدّدة.
تظهر هذه المبادرات كافة، على تنوّعها، حماساً إقليمياً واضحاً لتقليص الاعتماد على المورّدين الخارجيين، على الرغم من استمرار التحدّيات المرتبطة بالفجوات التكنولوجية ونقص الكفاءات وضيق حجم الأسواق. ومع ذلك، تحمل اضطرابات التجارة العالمية وقيودها والمخاطر الجيوسياسية حالة من عدم اليقين في طيّاتها. ولضمان النجاح، قد تحتاج الدول الخليجية إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلّبات المحتوى المحلّي والقدرة التنافسية، والاستثمار في نقل التكنولوجيا وتطوير القوى العاملة، إضافة إلى التعاون الإقليمي لتجنّب صناعات مشرذمة أو دون الحجم الأمثل، ما يُضعف قدرتها على المنافسة عالمياً.
الجدول 2: جهود توطين الطاقة المتجدّدة في دول مجلس التعاون الخليجي
| الدولة | إستراتيجية التوطين
|
| المملكة العربية السعودية | قائمة على المتطلّبات، تهدف إلى تحقيق نسبة 75 في المئة من التوطين في قطاع الطاقة بحلول 2030، ذات متطلّبات صارمة للمحتوى المحلّي في البرنامج الوطني للطاقة المتجدّدة (NREP). |
| سلطنة عُمان
|
قائمة على الاستثمار، ترتكز على المناطق الاقتصادية الخاصة والحوافز الضريبية لجذب الاستثمارات الأجنبية، ذات متطلّب متواضع للمحتوى المحلّي بنسبة 8 في المئة للمشاريع المعروضة من قبل الدولة. |
| الإمارات العربية المتحدة
|
قائمة على السوق، تستفيد من الشراكات العالمية ومرونة الأسواق، تستثمر في عمليات التعدين في شتى أنحاء أفريقيا من أجل تأمين المواد الخام لإنتاج الطاقة الشمسية والبطاريات. |
| قطر
|
ترتكز على توطين مراحل الإنتاج الأوّلية من خلال الاستثمار في إنتاج البولي سيليكون عبر شركة “QSTec”، لكنّها تفتقر إلى درجة ملموسة من الإدماج في مراحل التصنيع اللاحقة. |
| الكويت | جهود محدودة للتوطين، تعتمد على الواردات في البنى التحتية للطاقة المتجدّدة. |
| البحرين | جهود محدودة للتوطين، تعتمد على الواردات في البنى التحتية للطاقة المتجدّدة. |
توصيات السياسات والخاتمة
لا شكّ في أنّ مسعى الدول الخليجية لتوطين الطاقة المتجدّدة طموحٌ، ويأتي مدفوعاً بالاحتكاكات الجيوسياسيّة والتجاريّة التي تكشف عن مدى هشاشة سلاسل الإمداد العالمية. تُعزّز هذه التحدّيات عزم المنطقة على تقليص الاعتماد على الواردات وبناء سلاسل إمداد محلّية مرنة. وخلافاً للبنى التحتية القائمة للنفط والغاز، لا تزال سلسلة إمداد الطاقة المتجدّدة في الخليج في طور النمو، لا سيّما في مجالات التعدين وتكرير المعادن الحرجة، ومعالجة المكوّنات وتصنيعها، ودمج شبكات الكهرباء وتحديثها. قد تُعيق التكاليف الأوليّة العالية لتوطين الإنتاج وصغر السوق الإقليمية نسبياً، تحقيق وفورات الحجم اللازمة واستدامة صناعة محلّية للطاقة المتجدّدة، لا سيّما في غياب أسواق قوية للتصدير.
إنّ الطريق نحو التوطين الكامل محفوف بتحدّيات جسيمة. لا تزال الفجوات التكنولوجية ونقص الكفاءات تشكّل عوائق رئيسية. وتتطلّب عمليّات التصنيع المتقدّمة تقنياً، مثل إنتاج الرقائق الشمسية وتجميع خلايا البطاريات وتطوير تكنولوجيا المحوّلات المتقدّمة، مهارات متخصّصة تُعدّ نادرة في منطقة الخليج. وعلاوة على ذلك، تُعقّد المنافسةُ مع الصين، التي تهيمن صناعياً منذ عقود بفضل إنتاجها الضخم والمنخفض التكلفة والدعم المالي القوي من الدولة، الجهودَ الرامية إلى تحقيق إنتاج محلّي يتمتّع بقدرةٍ تنافسية من حيث التكلفة. إلى جانب ذلك، تجعل الأسواق المحلّية الصغيرة نسبياً في الخليج من الصعب تحقيق وفورات الحجم الضرورية للحفاظ على قدرة تنافسيّة مستدامة.
نظراً لهذه القيود، ينبغي على صنّاع القرار الخليجيين اعتماد إستراتيجيّة منسّقة طولية الأمد. تتمثّل الخطوة الأولى الحاسمة في إجراء مسح جيولوجي شامل على صعيد مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لتحديد رواسب المعادن الحرجة المحتملة وتقييمها، بما فيها الليثيوم والعناصر الأرضية النادرة والنيكل والكوبالت والمنغنيز. ومن شأن تأسيس مركز خليجي للبحث والتطوير في مجال المعادن الحرجة أن يمكّن المنطقة من تطوير تقنيّات مبتكرة وفعّالة من حيث التكلفة لاستخراج هذه المعادة وتكريرها ومعالجتها، بما يتلاءم مع ظروفها الجيولوجية والبيئية الفريدة. وتُعدّ مثل هذه المبادرات أساسية، ليس لتأمين المواد الخام فحسب بل أيضاً للحدّ من الاعتماد على المورّدين الخارجيين، في ظلّ بيئة تجارية عالمية تشهد حالة من عدم اليقين.
في المقابل، لا بدّ أن تركّز المنطقة على بناء قدرات التصنيع في المراحل المتوسّطة، بدلاً من السعي إلى تقليد سلسلة الإمداد المتكاملة في الصين بشكل شامل وفوري. ومن الضروري جذب الشركات الأجنبية وتحفيز القطاع الخاص في مجالات مثل معالجة مادة البولي سيليكون وإنتاج الرقائق الشمسية وتصنيع المواد الأولية للبطاريات، بالإضافة إلى إبرام اتفاقات متينة لنقل التكنولوجيا، ما سيجذب رؤوس الأموال ويُطوّر الخبرات المحلّية.
لا تقلّ معالجة التحدّي المتعلّق بالقوى العاملة أهميّةً عن غيرها من الأولويات. ينبغي على الدول الخليجية الاستثمار في برامج تدريب متخصّصة، وفي تعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديميّة والقطاع الصناعي، إلى جانب مبادرات التعليم المهني التي تساهم في بناء قاعدة محلّية من الكفاءات في مجالات مثل علوم المواد والهندسة الدقيقة وعمليّات التصنيع المتقدّمة. فمن دون هذه الاستثمارات، ستظلّ المنطقة تعتمد على العمالة الأجنبية إلى حدّ كبير، ما يقوّض استدامة جهودها الرامية إلى التوطين.
علاوة على ذلك، تتطلّب طبيعة السوق الخليجيّة المجزّأة مقاربةً إقليمية موحّدة. فخلافاً للصين التي استفادت من الطلب الداخلي الواسع لتعزيز توسّعها الصناعي، تُصعّب الأسواق الخليجية الصغيرة نسبياً والمشتّتة على أيّ دولة منفردة تحقيق الحجم المطلوب. وتُهدّد مقاربةٌ مجزّأة بخلق أوجه عدم كفاءة، إذ تمضي كلّ دولة في بناء صناعات موازية عوضاً عن الاستفادة من وفورات الحجم من خلال التعاون العابر للحدود. في المقابل، من شأن إستراتيجيّة صناعية خليجية منسّقة، تُوحّد السياسات والطلب، وتخصّص الاستثمارات بطريقة إستراتيجية بين الدول الأعضاء، أن تساعد على تخطّي هذه التحدّيات من خلال الحدّ من التكرار وخلق الحجم الضروري لضمان تنافسيّة الإنتاج المحلّي.
مع ذلك، تتمتّع منطقة الخليج بموقعٍ جيّد يُمكّنها من التعامل بمرونة مع المشهد الجيوسياسي المعقّد بين الولايات المتحدة والصين. وتُعدّ الشركات الصينية فاعلاً أساسياً في سوق الطاقة المتجدّدة، كما أنّها أكثر استعداداً من الشركات الغربية للانخراط في عملية نقل التكنولوجيا. وتُسلّط الحروب التجارية والنزاعات حول التعريفات الجمركية الدائرة حالياً، الضوء على أهميّة تنويع الشراكات من أجل تقليص الاعتماد على مورّدٍ واحد. بإمكان الدول الخليجية اغتنام هذه الفرصة من خلال تسخير صناديق ثروتها السيادية للاستثمار الإستراتيجي في أصول التعدين والتكرير والمعالجة على المستوى العالمي. ومن شأن هذه المقاربة أن توفّر تنوّعاً في مصادر الإمداد ويعزّز قدرة المنطقة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية. من خلال السعي للحصول على حصص ملكية في هذه القطاعات الحيوية، بإمكان منطقة الخليج تلبية احتياجاتها من الموارد وفي الوقت نفسه تقليص التحدّيات التشغيلية المرتبطة بتطوير المناجم وإدارتها. وبذلك، تترسّخ مكانة المنطقة كمكوّن أساسي لسوق الطاقة النظيفة العالميّة التي تتشكّل.
في نهاية المطاف، تواجه تطلّعات دول مجلس التعاون الخليجي لبناء سلسلة إمداد متكاملة للطاقة المتجدّدة مخاطر تكنولوجيّة ومالية ولوجستية، ناهيك عن التحدّيات المؤسّساتية. وفي ظلّ غياب جهود مستدامة لسدّ هذه الفجوات، ستبقى أهداف التوطين بعيدة المنال. ومع ذلك، تُعدّ هذه المساعي خطوة أولى في مسار طويل، يتطلّب اجتيازه بنجاح استثمارات مكثّفة في البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا والتعاون الإقليمي. ومن خلال توسيع نطاق تنمية الموارد المعدنية، وتدريب القوى العاملة على التصنيع في المراحل المتوسّطة، وتنسيق السياسات، يمكن للدول الخليجية الانتقال من استيراد تقنيات الطاقة المتجدّدة إلى الانخراط الفعّال في السوق العالمية للطاقة النظيفة. وفي العقود المقبلة، سيتمثّل الاختبار الحقيقي في قدرة هذه الإستراتيجيات على تحقيق استقلالٍ صناعي جذري، أو استمرار الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية.
الهوامش
1 يُقصد بسلاسل امدادات الطاقة المتجدّدة، الأدوار والعمليات المعنية، بما في ذلك التعدين والتكرير ومعالجة المعادن، وتصنيع المعدات، وتطوير المشاريع، ومقاولي الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، والمشغّلين، ومقدّمي التكنولوجيا، والمستخدمين النهائيين، والمعيدين للتدوير.
2 Li-Chen Sim, Steven Griffiths, “The Future of China-Gulf Solar and Wind Supply Chains,” Global Policy, online-only preview, December 22, 2024, https://doi.org/10.1111/1758-5899.13478.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Justin Dargin, “By Leveraging LNG, Qatar Can Fuel Fairness in Global Climate Policy,” Afkār (blog, Middle East Council on Global Affairs), January 20, 2025, https://mecouncil.org/blog_posts/by-leveraging-lng-qatar-can-fuel-fairness-in-global-climate-policy/.
6 تجدر الإشارة إلى أنّ هذه التوقّعات ترتكز على اتجاهات الأسواق والسياسات الحالية. تشدّد الوكالة الدولية للطاقة على أنّ اعتماد إجراءات سياسية أو تغيّرات سلوكية أكثر صرامة قد يُسرّع تراجع الطلب على النفط. وعلى الرغم من الذروة المتوقّعة، إلّا أنّ الوكالة تتوقّع زيادة في الطلب العالمي على النفط بنحو 3,2 مليون برميل في اليوم في العام 2030 مقارنة بالعام 2023، تُحرّكها بشكلٍ رئيسي الاقتصادات الناشئة في آسيا، لا سيما الهند، والاستخدام المتزايد لوقود الطائرات والمواد الأوليّة للبتروكيماويات. أنظر:
International Energy Agency (IEA), Oil Market Report: October 2024 (Paris, France: IEA, October 2024), 8, https://www.iea.org/reports/oil-market-report-october-2024; “Oil demand set to peak by 2029, major supply glut looms, IEA says,” Reuters, June 12, 2024, https://www.reuters.com/business/energy/oil-demand-set-peak-by-2029-major-supply-glut-looms-iea-says-2024-06-12/.
7 Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), World Oil Outlook 2050, (Vienna, Austria: OPEC, 2024), September, 2024, https://publications.opec.org/woo; International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook 2024, (Paris, France: IEA, October 2024), 24, https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2024.
8 Noam Raydan, “Gulf Energy Transition: Assessing Saudi and Emirati Goals,” The Washington Institute for Near East Policy, November 8, 2024, https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/gulf-energy-transition-assessing-saudi-and-emirati-goals.
9 Karim Elgendy, “Bracing for the Sandstorm: The Gulf Energy Transition Imperative,” Arab Center Washington DC, June 6, 2024, https://arabcenterdc.org/resource/bracing-for-the-sandstorm-the-gulf-energy-transition-imperative/.
10 Aisha Al-Sarihi, Abdalftah Hamed Ali, “Will COP28 Accelerate Climate Action in the Gulf and Beyond?” Afkār (blog, Middle East Council on Global Affairs), November 30, 2023, https://mecouncil.org/blog_posts/will-cop28-accelerate-climate-action-in-the-gulf-and-beyond/.
11 Faisal Al Azmeh, Michelle Della Vigna, Dalal Darwich, and Waleed Jimma, “GCC Capex Wave Series: The rise in low-carbon capex,” Equity Research Paper (New York: Goldman Sachs, November 28, 2023), 7, https://www.goldmansachs.com/insights/goldman-sachs-research/gcc-capex-wave-series-the-rise-in-low-carbon-capex.
12 International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Energy Markets: GCC 2023, (Abu Dhabi: IRENA, 2023), 18, https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2023/Dec/IRENA_Rnewable_energy_markets_GCC_2023.pdf; IRENA, Renewable energy statistics 2024, (Abu Dhabi: IRENA, 2024), https://www.irena.org/Publications/2024/Jul/Renewable-energy-statistics-2024.
13 IRENA, Renewable Energy Markets: GCC 2023,18.
14 IRENA, Renewable Energy Markets: GCC 2023,81.
15 “Qatar’s solar energy production capacity to reach 4,000 megawatts by 2030,” The Peninsula, April 29, 2025, https://thepeninsulaqatar.com/article/29/04/2025/qatars-solar-energy-production-capacity-to-reach-4000-megawatts-by-2030.
16 IRENA, Renewable Energy Markets: GCC 2023,18.
17 “Gulf turning green: West Asia now is the world’s biggest renewable energy market outside China,” FirstPost, January 29, 2025, https://www.firstpost.com/world/gulf-turning-green-west-asia-now-is-the-worlds-biggest-renewable-energy-market-outside-china-13857500.html.
18 عندما تُكلّف العمليات الحاسمة مثل إنتاج رقائق الطاقة الشمسية، وتجميع خلايا البطاريّات، وتصنيع المكوّنات الدقيقة إلى جهات خارجية، تفوّت المنطقةُ فرصة التعلّم التكراري والتحسّن المستمرّ التي تحقّز التقدّم التكنولوجي، ما يؤدّي إلى الاعتماد الكثيف على الواردات، ويُعيق خلق قوى عاملة محلّية ماهرة، ويقلّص الحوافز لاستدامة البحث والتطوير داخل المنطقة.
19 Li-Chen Sim and Karen E. Young, “What impedes solar energy deployment? New evidence from power developers in the Arab Gulf states,” Energy Policy, 156 (2021): 112404, https://doi.org/10.1016/j.esd.2024.101597.
20 بلغ الدعم الإجمالي للوقود في مجلس التعاون الخليجي في العام 2021 نحو 76 مليار دولار، خُصّص منها مبلغ 48 مليار دولار تقريباً لدعم النفط والغاز و28 مليار دولار لدعم الكهرباء. وعلى الرغم من الإصلاحات الواسعة النطاق المتعلّقة بالأسعار، تبقى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أكبر داعمين للوقود الأحفوري في العالم. أنظر تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة (IRENA): أسواق الطاقة المتجدّدة.
21 Sim and Young, “What impedes solar energy deployment?”
22 Rabah Arezki, Adnan Mazarei and Mark Plant, “What Will It Take to Achieve an Energy Transition in MENA?” The Forum / ERF Policy Portal (blog), January 22, 2023, https://theforum.erf.org.eg/2023/01/22/what-will-it-take-to-achieve-an-energy-transition-in-mena/.
23 تُشير عبارة “الاستدامة” إلى القدرة على تلبية الاحتياجات الحالية من دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتها الخاصة. وتشتمل على ثلاثة أبعاد: الاستدامة البيئية، التي تركّز على الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية والمحافظة على الأنظمة البيئية؛ والاستدامة الاقتصادية التي تتمحور حول النمو الاقتصادي الطويل الأجل الذي يفيد المجتمع من دون استنفاد الموارد؛ والاستدامة الاجتماعية التي تشتمل على ضمان وصول الجميع إلى الموارد والفرص على قدم المساواة.
24 يشتمل بعض إصلاحات الحوكمة على السياسات والهياكل المؤسساتية الآيلة إلى دعم التحوّل إلى الطاقة المتجدّدة بشكلٍ أفضل. وتتضمّن هذه التغييرات تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتمتين الأُطر التنظيمية، وتحديد الأدوار بين المرافق ووكالات الطاقة تحديداً واضحاً. وتُعدّ هذه الإصلاحات جوهرية لأنّها تخلق نظاماً أكثر شفافية وفعالية وقادراً على جذب الاستثمارات والحدّ من التأخير البيروقراطي وضمان تنسيق الجهود الرامية إلى اعتماد الطاقة المتجدّدة.
25 Sim and Young, “What impedes solar energy deployment?”
26 Ibid.
27 يمثّل إنتاج مادة البولي سيليكون، وهو شكل شديد النقاء من السيليكون وضروري للتقنيّات الشمسيّة الكهروضوئية، خطوةً مهمة نحو بناء سلسلة إمداد محليّة للطاقة المتجدّدة. ويشمل تصنيع الألواح الشمسية صناعة مختلف الأجزاء وتجميعها، بما فيها الرقائق والخلايا والزجاج والأغشية الخلفيّة وصناديق التوصيل والوصلات والإطارات. وتبدأ العمليّة بصناعة السيليكون الشديد النقاء على شكل رقائق، ثم تُجمع لاحقاً في وحدات وخلايا شمسيّة. أنظر:
“QSTec in talks with partners to develop solar, competitive industries globally,” Gulf Times, November 26, 2019, https://www.gulf-times.com/story/648611/qstec-in-talks-with-partners-to-develop-solar-competitive-industries-globally; “Polysilicon plant in final stages of construction,” Gulf Times, March 19, 2016, https://www.gulf-times.com/story/485232/polysilicon-plant-in-final-stages-of-construction.
28 تأسّست شركة “QSTec” كمشروعٍ مشترك بين مؤسّسة قطر للطاقة الشمسيّة وشركة “سولار ولرد آي دجي” الألمانية (SolarWorld AG) وبنك قطر للتنمية. أنظر:
“Qatar gets serious about solar,” Oxford Business Group, April 21, 2017, https://oxfordbusinessgroup.com/articles-interviews/qatar-gets-serious-about-solar; “Polysilicon plant in final stages of construction,” Gulf Times, March 19, 2016, https://www.gulf-times.com/story/485232/polysilicon-plant-in-final-stages-of-construction.
29 شركة “TechMet” هي أداة استثمارية مدعومة من شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية للمساعدة على تأمين إمدادات من المعادن الحرجة المستخرجة بشكلٍ مسؤول والحدّ من الاعتماد على الصين. أنظر:
“QIA to Invest $180 Million in TechMet,” August 7, 2024, https://www.qia.qa/en/Newsroom/Pages/QIA-to-Invest-$180-Million-in-TechMet.aspx
30 “Chinese firm to start $94m solar project work in Oman by year-end,” Times of Oman, September 17, 2017, https://timesofoman.com/article/42295-chinese-firm-to-start-94m-solar-project-work-in-oman-by-year-end.
31 Conrad Prabhu, “Oman’s $1.35 billion polysilicon project signs up service providers,” Oman Observer, July 11, 2024, https://www.omanobserver.om/article/1156198/business/economy/omans-135-billion-polysilicon-project-signs-up-service-providers.
32 “Wind Turbines Factory Launched in SEZAD,” Oman News Agency, April 13, 2025, https://omannews.gov.om/topics/en/80/show/121725/dark.
33 Will Owen, “Minerals Development Oman signs strategic agreement to explore silica resources,” Global Mining Review, October 22, 2024, https://www.globalminingreview.com/mining/22102024/minerals-development-oman-signs-strategic-agreement-to-explore-silica-resources/#:~:text=According%20to%20a%20Syndicated%20Analytics,US%24513.5%20million%20by%202027.
34 April A. Herlevi, China and the United Arab Emirates: Sustainable Silk Road Partnership?, China Brief Vol. 16, Issue 2, (Washington, D.C.: Jamestown Foundation, January 25, 2016), https://jamestown.org/program/china-and-the-united-arab-emirates-sustainable-silk-road-partnership/; Li-Chen Sim and Steven Griffiths, “The Future.”
35 Eleonora Ardemagni, Minerals (also) for Defence: Unlocking the Emirati Mining Rush, (Rome: Institute for International Political Studies (ISPI), July 23, 2024), https://www.ispionline.it/en/publication/minerals-also-for-defence-unlocking-the-emirati-mining-rush-181525.
36 Jonathan Gorvett, “How the UAE has made a global mining power grab,” Arabian Gulf Business Insight, November 4, 2024, https://www.agbi.com/analysis/mining/2024/11/how-the-uae-has-made-a-global-mining-power-grab/#mepr_jump.
37 International Resources Holdings, “IRH Completes the Official Acquisition Of Mopani Copper Mines In Zambia,” Press Release, March 7, 2024, https://www.irh.ae/irh-completes-the-official-acquisition-of-mopani-copper-mines-in-zambia/.
38 Gorvett, “Power Grab”; Gracelin Baskaran, Partnering with Middle Eastern Countries to Boost U.S. Minerals Security (Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies, September 6, 2024), https://www.csis.org/analysis/partnering-middle-eastern-countries-boost-us-minerals-security.
39 Antonio Cascais, “How Sahel states ditched Western mining interests,” Deutsche Welle, February 14, 2025, https://www.dw.com/en/lithium-uranium-gold-how-sahel-states-ditched-western-mining-interests/a-71583132; Business & Human Rights Resource Centre, “Congo wants to pivot away from China’s dominance over its mining,” October 2024, https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/drc-wants-to-pivot-away-from-chinas-dominance-over-its-mining-sector/.
40 حدّدت المملكة العربية السعودية في العام 2017 متطلّبات المحتوى المحلّي (LCRs) لمناقصات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحيث ركّزت على التصميم التقني، والمواد الخام، والتصنيع، واللوجستيات، والدعم التقني. واستخدمت مقياس الامتثال للسَعودة التابع للبرنامج الوطني للطاقة المتجدّدة (NREP) لتقييم الإنفاق الرأسمالي المحلّي في الجولة الأولى من عروض مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجدّدة. للمزيد من التفاصيل، أنظر:
“Kingdom of Saudi Arabia National Renewable Energy Program Seeks Bids for First Utility Scale Wind Power Project,” Saudi Press Agency (SPA), August 29, 2017, https://www.spa.gov.sa/1661275.
41 يتضمّن الاحتساب أربعة عناصر: العمالة (التعويض للموظفين المعنيين)، وبناء القدرات (تدريب السعوديين وتطويرهم وتنمية الموردين داخل الممكلة والبحث والتطوير)، والإهلاك (إهلاك الأصول داخل المملكة)، والسلع والخدمات (المشتريات)، أي الإنفاق على السلع والخدمات الضرورية بناءً على نسبة المحتوى المحلي. للمزيد من التفاصيل:
Robin von Hammerstein, Hamid Can Baş, “The business of localization: “Insights for success in the Saudi renewables market,” Apricum, December 9, 2020, https://apricum-group.com/the-business-of-localization-insights-for-success-in-the-saudi-renewables-market-2/?cn-reloaded=1.
42 Li Dan and Majed Al Suwailem, Saudi-China Collaboration on Renewable Energy Supply Chains, Workshop Brief (Riyadh, Saudi Arabia: King Abdullah Petroleum Studies and Research Center / KAPSARC, March 21, 2023), 11, https://www.kapsarc.org/research/publications/saudi-china-collaboration-on-renewable-energy-supply-chains/.
43 Ibid, 13.
44 Saudi Arabia, Public Investment Fund, “PIF strengthens renewable energy localization in Saudi Arabia with three new joint ventures,” Press Release, July 16, 2024, https://www.pif.gov.sa/en/news-and-insights/press-releases/2024/pif-strengthens-renewable-energy-localization-in-saudi-arabia-with-three-new-joint-ventures/.
45 Gracelin Baskaran, “Saudi Arabia Has a Strategic Advantage in Sourcing Critical Minerals from Africa,” CSIS, December 5, 2023, https://www.csis.org/analysis/saudi-arabia-has-strategic-advantage-sourcing-critical-minerals-africa.
46 Cecilia Jamasmie, “Saudi Arabia to scale up lithium expansion as it diversifies from oil,” MINING.COM,
January 15, 2025, https://www.mining.com/saudi-arabia-to-scale-up-lithium-expansion-as-it-diversifies-from-oil/.
47 Vanessa Ghanem, “Can Saudi Arabia’s solar manufacturing initiative be a game changer?” Al Arabiya English, September 18,2024, https://english.alarabiya.net/News/saudi-arabia/2024/09/18/can-saudi-arabia-s-solar-manufacturing-initiative-be-a-game-changer.
48 منارة هي مشروع مشترك بين شركة معادن وصندوق الاستثمارات العامة (PIF)؛ وتشكّل مشاريع استخراج الليثيوم ثمرة التعاون بين شركة أرامكو السعودية وشركة معادن ومؤسسات بحثية مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST). أنظر:
Valentina Pasquali, “Critical minerals become a Middle East battleground,” Arabian Gulf Business Insight, December 4, 2024, https://www.agbi.com/analysis/mining/2024/12/critical-minerals-saudi-arabia-uae-mining-industry, Edmund Bower, “Ma’aden aims to be world’s most valuable mining company,” Arabian Gulf Business Insight, February 12, 2025, https://www.agbi.com/mining/2025/02/maaden-aims-to-be-worlds-most-valuable-mining-company/.
49 Meike Schulze, Mark Schrolle, “Saudi Arabia strives to become major player in mineral supply chains,” PubAffairs Bruxelles, November 19, 2024, https://www.pubaffairsbruxelles.eu/opinion-analysis/saudi-arabia-strives-to-become-major-player-in-mineral-supply-chains/.
50 Pesha Magid, “Saudi Arabia has extracted lithium from oilfield runoffs, vice minister says,” Reuters, December 18, 2024, https://www.reuters.com/markets/commodities/saudi-arabia-has-extracted-lithium-oilfield-runoffs-vice-minister-says-2024-12-17/
51 تتوقّع شركة أرامكو أن ينمو الطلب المحلّي على الليثيوم مقدار عشرين ضعفاً بين عامي 2024 و2030، ما يُساهم بنحو 500 ألف بطارية مركبة كهربائية و110 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجدّدة. أنظر:
Leslie Hook, Ahmed Al Omran, “Saudi Aramco to expand investments in lithium as it diversifies from oil,” Financial Times, January 15, 2025, https://www.ft.com/content/d34952bc-f103-4f30-bdf9-363a37e5c610.
52 “Saudi Arabia’s lithium production set to begin by 2027 with Aramco and Ma’aden JV,” Saudi Gazette, January 15, 2025, https://www.saudigazette.com.sa/article/648610/SAUDI-ARABIA/Saudi-Arabias-lithium-production-set-to-begin-by-2027-with-Aramco-and-Maaden-JV#google_vignette.
53 Pramod Kumar, “Saudi Arabia secures $9bn to unlock mining potential,” Arabian Gulf Business Insight, November 27, 2024, https://www.agbi.com/mining/2024/11/saudi-arabia-secures-9bn-to-unlock-mining-potential/.
54 اشترت المملكة العربية السعودية حصّة بنسبة 10 في المئة من شركة “فالي للمعادن الأساسية” (Vale Base Metals) بقيمة 2,5 مليار دولار، ضامنةً الوصول إلى أصول النيكل في البرازيل وكندا وإندونيسيا. أنظر:
Baskaran, Partnering with Middle Eastern Countries to Boost U.S. Minerals Security.
55 Pasquali, “Critical minerals become a Middle East battleground.”
56 Syndicated Analytics, GCC Silica Sand Market by End-Use (Glass Industry, Foundry, Hydraulic Fracturing, Filtration, and Abrasives); Industry Analysis, Trends, Growth and Forecast 2023-2028, (U.S.: Syndicated Analytics, 2024), https://www.syndicatedanalytics.com/gcc-silica-sand-market; Will Owen, “Minerals Development Oman.”




